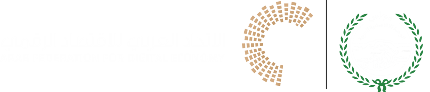أبوظبي
المصدر: جريدة الاتحاد
مفكرو الإمارات
أ.د. علي محمد الخوري
تتبدى مُعضلة التنمية المستقلة والتكاملية في العالم العربي بصفتها أحد أعقد الملفات التي تواجه المنطقة في القرن الحادي والعشرين، فبين وعود النهضة التي رافقت مشروعات الدولة الوطنية بعد الاستقلال، وواقع الاقتصادات الريعية، والانقسامات السياسية والاجتماعية، ظل المشروع التنموي العربي مُعلقاً في منتصف الطريق. ولا تكمن المشكلة في بطء التنفيذ، أو محدودية الموارد فحسب، بل في تجذُّرها داخل ميراثٍ ممتد من الأعطاب السياسية والاقتصادية والفكرية، ما جعل التنمية هدفاً مؤجلاً أكثر مما هي مسار متصل وقابل للاستدامة.
المدخل الأول لفهم هذا المأزق يكمن في البنَى السياسية والمؤسسية، فرغم كثرة الاتفاقيات والمواثيق العربية المشتركة، فإنها غالباً ما بقيت مُجمدةً، إذ لم تتوافر الإرادة السياسية لترجمتها إلى برامج عملية. وهذا العجز يرتبط بغياب ميثاقٍ سياسي إقليمي يربط بين السيادة الوطنية، والمصالح الجماعية، ويمنح المؤسسات المشتركة قدرةً حقيقيةً على الالتزام والمتابعة، فما زالت الصراعات الأهلية، والنزاعات الحدودية، والتجاذبات الجيوسياسية، تستهلك المواردَ، وتشتت الاهتمام بعيداً عن التنمية. ونتيجة مباشرة لهذا الواقع، فإن المنطقة تعيش ما يمكن تسميته «معضلة الأمن الدائم»، إذ تُستنزف الطاقات في إدارة المخاطر بدلاً من استثمارها في بناء المستقبل، بما ينسجم مع أطروحات نظرية «معضلة الأمن» في العلاقات الدولية، التي تشرح كيف يضعف غياب الثقة المشتركة إمكانَ قيام تكاملٍ اقتصادي وسياسي فعال.
وإلى جانب العوامل السياسية، يَظهر الاقتصاد الريعي بصفته أحد معوقات التنمية المستقلة، فمعظم الدول العربية ما تزال تعتمد اعتماداً مفرطاً على صادرات النفط والغاز، ما يجعل موازناتها العامة وأسواق عملها أسيرةً لتقلبات الأسعار العالمية، وما تخلِّفه من صدماتٍ دورية. وتمثل هذه البنية الاقتصادية ما يُسمى «فخ الموارد»، إذ تفضي المداخيل النفطية إلى إضعاف التنويع الاقتصادي، وتكريس دور الدولة موزِّعاً للثروة، لا محفِّزاً للإنتاج والإبداع. وقد شكَّل انهيارُ أسعار النفط في عام 2020، وما ترتب عليه من انكماشٍ في الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة تجاوزت 4 في المئة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، لحظةً كاشفةً لخلل النموذج الاقتصادي السائد، إذ أظهر أن الاقتصادات التي تستند إلى عوائد خاملةٍ، وغير إنتاجية، تفتقر إلى المناعة أمام تقلبات النظام المالي العالمي، وتغدو عرضةً للتآكل مع أي تبدُّلٍ في شروط السوق الدولية. ففي عالمٍ يتجه بسرعة نحو الطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، يبدو الارتهانُ الأحادي للريع النفطي رهاناً خاسراً على ماضٍ يتلاشى لا على مستقبلٍ يتشكل. وإذا كان الاقتصاد الريعي يكشف عن حدود النموذج الاقتصادي، فإن الواقع الاجتماعي يكشف عن حدود رأس المال البشري في العالم العربي، فمعدلات البطالة بين الشباب العربي تبقى الأعلى عالمياً، إذ تجاوزت 24 في المئة عام 2024 وفقاً لمنظمة العمل الدولية، ما يعني أن جيلاً كاملاً مهدداً بالإقصاء عن دورة الإنتاج والاستهلاك، في لحظة تاريخية تحتاج فيها المنطقةُ بشدة إلى قوة عملٍ ماهرةٍ ومبدعة.
أما الإنفاق على البحث والتطوير فلا يكاد يُذكر، إذ لا يتجاوز في معظم الدول العربية 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمتوسط عالمي يزيد على 2.5 في المئة، وهذا الفارق يعكس فجوةً معرفيةً عميقة، تُكرِّس تبعيةَ المنطقة لمراكز إنتاج المعرفة في الغرب والشرق، وتحرمها من صياغة نموذجها التنموي الخاص. وفي السياق نفسه، لا تزال البنية التعليمية عاجزة عن إنتاج جيلٍ يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الجديد، فالمناهج تركز على التلقين بدلاً من التفكير النقدي، وتفتقر إلى الروابط المباشرة مع القطاعات الاقتصادية الناشئة. والنتيجة: وفرة من الخريجين الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية والابتكارية، يقابلها عجزٌ في الكفاءات التقنية، ما يوسِّع الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ويحوّل الشباب من قوةٍ دافعةٍ للتنمية إلى طاقةٍ معطَّلة. وفي المقابل تكشَّف ضعف البنية المؤسسية للتكامل الاقتصادي عن معضلةٍ مزمنةٍ أخرى، فالتجارة العربية البينية لا تتجاوز 14 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية، وهي نسبةٌ ضئيلة مقارنةً بتكتلاتٍ كبرى كالاتحاد الأوروبي، إذ تتخطى 60 في المئة. وهذا الواقع يعكس تعثرَ مشروع السوق العربية المشتركة، الذي ظل حبيس الشعارات من دون تنفيذ، فالعوائق اللوجستية، وضعف البنية التحتية للنقل والاتصالات، وغياب التنسيق التشريعي.. تجعل التجارة الإقليمية عمليةً مكلفةً، وغير تنافسية، وتدفع كل دولة إلى عقد اتفاقاتها الفردية مع شركاء خارجيين، ما يزيد تفكك الموقف الجماعي، ويُضعف القدرةَ على الدفاع عن المصالح المشتركة.
غير أن الخلل الأخطر لا يكمن في السياسة أو الاقتصاد منفصلَين، بل في العلاقة بينهما، فالتوتر القائم بين الممارسات السياسية وتوزيع الموارد والفرص، أفرز قاعدةً اجتماعيةً ضعيفةً للتنمية، وجعل المواطن العربي يشعر بأن التنمية مشروعٌ حكومي فوقي، لا مسار تشاركي يشارك فيه المجتمع. إن ضعف المجتمع المدني، وغياب آليات المشاركة، والقيود على حرية التنظيم والعمل الأهلي، كلها عوامل حرمت التنميةَ من رافعتها الأساسية: الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. وتمثل هذه الفجوة، من منظور الاقتصاد المؤسسي، إحدَى أعظم العوائق أمام أي تحولٍ مستدام، لأن التنمية لا تقوم إلا على العدالة والانتماء، وعلى قناعة المواطن بأن مستقبله جزءٌ من مستقبل وطنه. ولذلك فأي رؤيةٍ جادةٍ للتنمية المستقلة والتكاملية في العالم العربي لا يمكن أن تنجح من دون إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتحديد موقع المنطقة ضمن البنيتين الاقتصادية والسياسية العالميتين، فالاستقلال لا يعني الانعزال، بل امتلاك القدرة على الدخول في التبادلات الدولية من موقعٍ يملك أدوات الإنتاج والمعرفة والتأثير. والتكامل لا يقتصر على إزالة الحواجز بين الأسواق، بل يقوم على تأسيس بنى مؤسسيةٍ مشتركةٍ تملك سلطةً فعليةً في صياغة السياسات، وتنسيق الأولويات، لتحويل الخطاب الوحدوي من شعار عاطفي إلى آليةٍ عمليةٍ لإنتاج مصالح جماعية مستدامة.
ما تحتاج إليه المنطقة، في جوهره، هو إطار يعيد ترتيبَ الأولويات، ويمنح التنميةَ موقعَها المركزي بدلاً من أن تبقى ملفاً ثانوياً تحكمه الاعتبارات الأمنية. ولعل أحد المسارات الممكنة هو إنشاء هيئة عربية مستقلة تُعنى بالسياسات التنموية، مزودة بصلاحيات إلزامية في مجالات محددة مثل المشتريات المشتركة، وتوحيد المعايير الصناعية، وتمويل البحث العلمي المشترك. إن وجود مثل هذه المؤسسة لا يلغي الأطرَ التقليدية كجامعة الدول العربية، بل يمنحها بعداً تنفيذياً طالما افتقر إليه العمل العربي المشترك، ويحول الخلافات إلى حوار مؤسسي منظم بدلاً من أن تكون ذريعةً لتعطيل التعاون. أما في الشق الاقتصادي فالمطلوب هو انتقالٌ جذريٌّ من الفكر الريعي إلى الفكر الإنتاجي، ولن يتحقق ذلك بالشعارات حول التنويع الاقتصادي، بل عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات الاقتصادين الأخضر والرقمي والصناعات الإبداعية.
ويمكن لصندوق سيادي عربي مشترك أن يكون الأداةَ الماليةَ لهذا التحول، بتمويل المشروعات العابرة للحدود في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، مقابل التزام الدول الأعضاء بفتح أسواقها لهذه المنتجات. وعندها فقط يمكن للمنطقة أن تنتقل من اقتصاد يصدِّر الموارد إلى اقتصاد ينتج المعرفة والابتكار.

وفي المقابل يحتاج الجانب الاجتماعي إلى ثورة تعليمية ومعرفية شاملة تعيد صياغة المناهج بما يتلاءم مع الاقتصاد الجديد، فالمطلوب ليس إدخال التكنولوجيا في التعليم فحسب، بل تغيير فلسفته جذرياً، ليُبنى على التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. كما يجب تحويل البحث العلمي إلى محركٍ اقتصادي فعال، من خلال ربط الجامعات بالقطاع الخاص، وتخصيص منحٍ تنافسية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة.
أما المجتمع المدني فينبغي أن يستعيد دوره شريكاً أصيلاً في التنمية، لا مراقباً هامشياً؛ فالمبادرات المحلية، ومنظمات العمل الأهلي، قادرة على سد الفجوات في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، ولكنها تحتاج إلى بيئة قانونية ومالية تتيح لها العمل بسلاسة. ويمكن أن تتحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إلى نموذج جديد للتنمية التعاقدية، تُقاس نتائجُه بمؤشرات واضحة، مثل معدلات التوظيف وحجم الابتكار المحلي.
ما تحتاج إليه المنطقة ليس خطةً جديدةً تُضاف إلى رفوف الخطط السابقة، ولكنها تحتاج إلى تغيير جذري في مفهوم التنمية نفسه، فالتنمية ليست مجرد زيادة في الناتج المحلي، أو تراكماً في رأس المال، بل هي –كما يؤكد مفكرو الاقتصاد الأخلاقي– عمليةُ توسيعٍ لقدرات الإنسان على أن يكون ويفعل. وحين يصبح هذا المبدأ أساساً للسياسات العامة تتحول التنمية من برنامجٍ حكومي محدود إلى مسارٍ اجتماعي وثقافي شامل يجعل من المواطن غاية التنمية ووسيلتها. لن يُحسم مستقبل التنمية في العالم العربي بكمِّ الخطط، أو حجم التمويل، بل بمدى القدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى منظومةٍ إنتاجية معرفية واقتصادية مستدامة، فالمؤشرات الراهنة من الاعتماد المفرط على العوائد النفطية، والبطالة الشبابية المرتفعة، والإنفاق المتواضع على البحث العلمي، تكشف عن حدود الممكن إذا استمرت السياسات على حالها.
والتحدي الحقيقي إذن هو الانتقال من اقتصادٍ يستهلك طاقاته إلى اقتصادٍ يستثمرها في الإنسان والتعليم والتكنولوجيا. وبهذا المعنى تصبح التنمية المستقلة والتكاملية خياراً وجودياً للدول العربية، فإما أن تنجح المنطقة في بناء منظومة إنتاجية قادرة على الصمود في عالمٍ يتغير بسرعة غير مسبوقة، أو تظل أسيرةَ دورها الهامشي في الاقتصاد العالمي. واللحظة الراهنة ليست زمنَ التردد، بل لحظة الفعل: التفكير العملي في سياسات واقعية مثل الصناديق السيادية العابرة للحدود، والاستثمارات المشتركة في الاقتصادين الأخضر والرقمي، والمشروعات البحثية الإقليمية المرتبطة بسوق العمل، وعندها فقط يمكن للعالم العربي أن ينتقل من التبعية البنيوية إلى السيادة الاقتصادية، ومن الخطط الموسمية إلى استراتيجياتٍ منتجةٍ للقيمة.