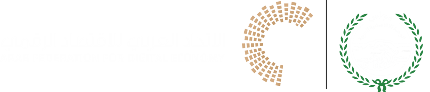أبوظبي
المصدر: مفكرو الإمارات
أ.د. علي محمد الخوري
ِمنذ نهاية الحرب الباردة تبلور النظام الاقتصادي العالمي تحت مظلة ليبرالية تقودها مؤسسات دولية تتخذ من الغرب مقرًّا ومرجعية؛ وقد ارتكز هذا النظام على مبادئ السوق الحرة القريبة من المنهج الرأسمالي. وخلال العقود الثلاثة الماضية سادت تصورات بأن العالم يسير نحو تكامل اقتصادي متسارع تقوده كفاءة الأسواق، وانسياب التجارة، وحوكمة مؤسساتية عابرة للحدود؛ غير أن عام 2025 جاء مخالفًا لهذه التصورات؛ إذ بدأ يمهد لمنعطف تاريخي قد يعيد تشكيل علاقات القوى الاقتصادية في مشهد يشبه إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية بصيغة اقتصادية.
دخل العالم اليوم مرحلة تتآكل فيها دعائم العولمة التقليدية، لتحل محلها بنية جيو-اقتصادية جديدة تتسم بالتعددية القطبية، وتقوم على منطق الصراع على السيادة الاقتصادية بدل التعاون العابر للحدود.
صدمة التعريفات الجمركية
في 23 مايو 2025 فاجأت الولايات المتحدة العالم بإعلانها زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية بنسبة 50% على الواردات الأوروبية، و25% على أجهزة الآيفون المصنعة خارج أراضيها. وقد تجاوزت قراءة المحللين لهذا القرار أنه خطوة سياسية ظرفية أو عابرة؛ إذ رأوا فيه تجسيدًا لتحول استراتيجي يعيد تعريف المصلحة الوطنية الاقتصادية عبر نقل مركز الثقل نحو الداخل الأمريكي على حساب الروابط الاقتصادية المُعولمة.
ووفقًا لتقديرات مؤسسة “باركليز”، وهي إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية، فإن هذه الإجراءات، التي ضاعفت تقريبًا الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوروبية، قد تُلحق بالاقتصاد الأمريكي خسائر تقدر بنحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو السنوي؛ نتيجة التباطؤ في قطاعي الصناعة والتصدير، وما ينجم عن ذلك من آثار في سوق العمل والدخل القومي.
وأما على المستوى العالمي، فتُرجّح منظمة التجارة العالمية تراجعًا في حركة تجارة السلع بنحو 0.2%، وهي نسبة تُخفي وراءها خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وتعكس مؤشرات مقلقة إلى انكماش اقتصادي أوسع قد يطول الاقتصادات الكبرى إذا استمرت عدوى السياسات الحمائية في الانتشار بين هذه القوى.
واللافت للنظر أن شركات التأمين والائتمان الدولية، مثل “أليانز تريد (Allianz Trade)، كشفت أن نحو نصف الشركات العالمية تتوقع تراجعًا كبيرًا في صادراتها نتيجة موجة السياسات الحمائية الأخيرة، مقارنة بنسبة 5% فقط قبل صدور القرارات الأمريكية. ويعكس هذا التحول المفاجئ مدى عمق الصدمة التي أصابت آليات التجارة الدولية، ويؤكد أن العالم لا يواجه اضطرابات مرحلية فحسب، بل يشهد تحولات بنيوية أيضًا قد تُنهي حقبة الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات والأنماط التي قامت عليها العولمة.
تفكك النموذج النيوليبرالي
تتجاوز الأحداث الراهنة حدود النزاعات التجارية التقليدية، وتجسد تداعيًا مباشرًا لانهيار فرضيات “الربح المشترك” التي كانت تشكل أساس النظام التجاري العالمي لعقود؛ فالنموذج النيوليبرالي، الذي افترض أن حرية الأسواق تصنع العدالة، وأن التكامل الاقتصادي يقود إلى السلم، يجد نفسه في مهب عاصفة بعد عقود من التآكل الاجتماعي، وتنامي اللامساواة، وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية.
ومع تصدع ركائز الإجماع القديم استعادت السيادة الاقتصادية مركزها بصفتها أولوية تتقدم على اعتبارات التكاليف المنخفضة. ولم تعد الدول تكتفي بالاعتماد على سلاسل التوريد العالمية، بل باتت تتجه نحو توطين صناعاتها الحيوية داخل حدودها الوطنية، بصفته خِيارًا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا يمنحها هامش أوسع للتحرك من دون أن تكون رهينة لقرارات أو أزمات الآخرين.
أزمة التضخم وسلاسل التوريد
الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن الإجراءات الحمائية تحمل تكلفة باهظة؛ إذ تشير بيانات “مصلحة الضرائب” الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة هذا العام إلى أعلى مستوًى له منذ أكثر من ثمانين عامًا، ليبلغ 12.1%. وهذه الزيادة تعني أن الأسرة الأمريكية ستدفع، بصورة غير مباشرة، نفقات إضافية تتجاوز 1,155 دولارًا سنويًّا، وهو ما يعادل في بعض الولايات ميزانية شهر كامل للسلع التموينية والسكن. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي يُتوقع أن يؤدي هذا العبء إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 0.8%، وهي نسبة كافية لدفع بعض القطاعات إلى الركود أو تقليص التوظيف.
ويتمثّل الأثر الأعمق لما يحدث اليوم في التحول داخل سلاسل التوريد العالمية التي طالما اعتمدت على اختيار مواقع الإنتاج بناءً على الكفاءة وتكاليف التشغيل؛ غير أن هذا المنطق تغير، فالشركات والدول لم تعد تختار شركاءها بناءً على معيار التكلفة فقط، بل صارت تفضّل أيضًا الطرف الأكثر أمانًا على المدى البعيد؛ أي الطرف الذي يُرجَّح أن يحافظ على علاقات سياسية مستقرة، ولا يكون عُرضة لتقلبات حادة، كالعقوبات أو النزاعات.
إن هذا التحول من مبدأ الكفاءة إلى مبدأ “الأمان الجيوسياسي”، دفع العديد من الشركات إلى نقل مصانعها من دول، مثل الصين، إلى دول تراها أكثر توافقًا سياسيًّا معها ولو كانت تكلفة ذلك أعلى. والنتيجة المتوقعة هي موجات تضخمية مستقبلية؛ لأن المستهلك سيدفع مقابل هذا “الأمان” مبالغ عليا.
وكانت الشركة الأمريكية “جنرال إلكتريك”، على سبيل المثال، تُصنِّع أجزاءً من أجهزتها في جنوب شرق آسيا بتكلفة منخفضة؛ ولكنها بدأت اليوم، تحت وطأة الضغوط السياسية ومخاوف الاعتماد على الصين، تنقل هذه العمليات إلى المكسيك أو الداخل الأمريكي؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة تراوحت بين 12% و18%، وفقًا لتقارير نشرتها وكالة بلومبيرج في أوائل عام 2025.
عودة الاقتصاد السياسي
تُعلّمنا نظريات الاقتصاد السياسي أن الأسواق لا تتحرك بمعزل عن السياق السياسي، بل هي دائمًا مشروطة بتوازنات القوة والمصالح. وما نراه اليوم هو عودة السياسة -التي طالما أُقصيت من واجهة النقاش الاقتصادي- لتصبح المحرّك الأساسي للقرارات الاقتصادية الكبرى، بعد سنوات طويلة بدا فيها أنها دُفعت إلى الخلف باسم العولمة والانفتاح.
إذن، نحن لا نعيش مجرد تغيّرات ظرفية، بل نشهد انتقالًا جذريًّا من عالم كانت الأسواق تتحرك فيه بحرية عبر الحدود، شبه منفصلة عن قرارات الدول، إلى عالم تُعيد فيه الدولة دورها بصفتها مقرّرًا أول في الشأن الاقتصادي؛ فلم تَعُد الحكومات تكتفي بدور المُنظّم أو المراقب، بل أصبحت هي التي تُحدّد، وبشكل مباشر، مع من تُتاجر، وأين تُنتج، وبأي شروط تُفتح الحدود أو تُغلق.
وهذا التحول يعيدنا إلى نظريات كارل بولاني، المفكر النمساوي المجري، الذي حذر في أربعينيات القرن العشرين من “التحول الكبير” بأن المجتمعات قد تتفكك إن تُركت قوى السوق تعمل بلا حدود أو ضوابط. كما يرى بولاني أن الاقتصاد لا ينفصل عن القيم والسياسة والمجتمع، وأن تجاهل هذا الترابط يؤدي إلى انفجارات اجتماعية أو أزمات مؤسسية.

وعلى امتداد هذا المنظور تتجسد تحذيرات بولاني اليوم في معاناة الدول الصغيرة والنامية؛ فمع تراجع التكامل الاقتصادي العالمي، وانكماش شبكات الاعتماد المتبادل، تجد هذه الدول نفسها خارج دوائر الحماية التي كانت توفرها بنية السوق العالمية، بعدما بنت نماذج نموها على الانفتاح وتكامل سلاسل التوريد. ومع تراجع التكامل، تواجه هذه الدول اليوم وضعًا جديدًا تُغلق فيه الأسواق، وتُقيّد فيه حركة السلع والتكنولوجيا، وتُعاد فيه صياغة شروط الشراكة الاقتصادية.
وفي ظل هذه الأوضاع الجديدة، يصبح الاعتماد على الذات -مع غياب منظومة اقتصادية دولية جامعة- أكثر من مجرد تحدٍّ تنموي، بل يغدو عبئًا هيكليًّا قد يُفضي إلى تضخم مزمن، ونقص في الإمدادات، وربما اختلالات اجتماعية تهدد الاستقرار الداخلي، وهذا تمامًا ما كان بولاني يحذّر منه.
التعامل مع قواعد اللعبة الجديدة
للتعامل مع المعطيات الحالية، لم يَعُد كافيًا أن تتكيف الدول مع المتغيرات؛ بل لا بد من سياسات استباقية تُعيد تعريف الأولويات الوطنية ضمن المشهد العالمي المُتقلب. وينبغي إعادة النظر في هيكلة الشراكات الاقتصادية؛ بحيث تُبنى التحالفات على أسس التنوع الجغرافي والتكافؤ السياسي، لا على العوائد أو الرؤى القصيرة الأجل. ولا بد أن تتحول الاستثمارات في الاقتصاد المحلي إلى مشروع وطني متكامل، يشمل إعادة توطين الصناعات الحيوية، ويشجع البحث العلمي، وبناء قدرات بشرية تستطيع التفاعل مع الاقتصاد العالمي المُعقّد وغير المستقر.
ولم تَعُد مسألة سلاسل التوريد تفصيلًا ثانويًّا في الأجندات الوطنية، بل هي من ضروريات الأمن القومي وركائزه؛ وهو ما يفرض بناء شبكات إنتاج مرنة ومتعددة المسارات تستطيع الصمود في وجه الأزمات، واستثمارًا فعليًّا في أدوات التتبع اللوجستي لحركة السلع من المصدّر إلى المستورد، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، وتبنّي الحلول الرقمية التي تجعل “المرونة” قدرة تشغيلية تُمكن الدول من حماية إمداداتها الحيوية، والاستجابة الاستباقية والسريعة للأزمات المفاجئة.
وفي خضم هذا الميل المتزايد نحو الحمائية، لا بد من الحفاظ على حد أدنى من التعاون الدولي على أقل تقدير. وبرغم التوترات التجارية المتزايدة؛ فإن المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، تظل أطرًا حيوية لضبط قواعد التجارة ومنع الانزلاق إلى فوضى اقتصادية. إن وجود أساس مشترك، وإن كان محدودًا، سيوفر إطارًا قانونيًّا وتنظيميًّا لحل النزاعات وتجنب الصدامات التي قد تنشأ من غياب القوانين الواضحة.
الاقتصاد السياسي الجديد في رماد العولمة
إن ما نشهده اليوم ليس أزمة طارئة، بل لحظة يُعاد فيها تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، يتخلّق من رحم الصراعات الدائرة، وعدم اليقين، والتحولات في مراكز القوى العالمية. وإن الدول التي تملك القدرة على قراءة اللحظة بذكاء استراتيجي ستكون أقدر على صياغة مستقبلها.
ولهذا، فإن الأسئلة الحقيقية التي ينبغي أن تتصدر أجندات صانعي السياسات لا يمكن أن تحصر في منحاها التقليدي أو الفني المُجرد، بل يجب أن ترتقي إلى التساؤل عن محددات وجودية تمس جوهر النظام العالمي الجديد قيد التشكل، من قبيل: من يتحكم في الإنتاج؟ وأين يُنتج؟ ولمن؟ ومن يتحكم في مسارات التكنولوجيا المتقدمة؟ ومن يملك أدواتها؟ ومن يمسك مفاتيح القرار في شبكات الإنتاج العابرة للحدود التي تُعيد اليوم رسم خرائط النفوذ والسيادة؟
وقد تؤطَّر هذه الأسئلة في مجال التساؤلات الاقتصادية، ولكنها في الأصل تمثل بوابات لفهم السّلطة في شكلها الجديد، السّلطة التي لم تَعُد تقتصر على الحدود الجغرافية أو الترسانة العسكرية، بل تتجلى فيمن يتحكم في التكنولوجيا، وتدفّق المعلومات، والموارد الحيوية، وإيقاع السوق.
وقد لا نملك اليوم جميع الإجابات، ولا الفهم الكافي للشكل المتوقع للنظام الاقتصادي العالمي الجديد؛ فالعالم لا يزال قيد التشكّل، وتُعاد فيه صياغة الموازين، وتُختبر فيه المسلمات القديمة. ولكن الثابت وسط هذا التحول وما يجب أن يعيه صانعو السياسات هو أن الاقتصاد لم يَعُد مجرد منظومة حسابية تُقاس بالأرقام والنسب، بل أصبح ميدانًا تُمارَس فيه السلطة، ويُعبّر بها عن الإرادة السياسية العميقة للدول والمجتمعات، وتُصاغ عبرها مفاهيم الانتماء، والمصلحة، والهوية.
العالم يعيد صياغة قواعده الآن، ومن يقرأ اللحظة بذكاء استراتيجي، سيكون مشاركًا في كتابة الفصل المقبل من التاريخ؛ فمن يُدرك التحولات في أثناء تشكلها، سيكون في موقع القيادة حين تستقر. وهذه قاعدة لا تتغير.