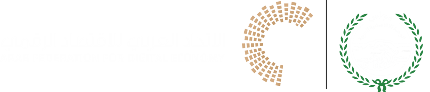أبوظبي
المصدر: جريدة الاتحاد
مفكرو الإمارات
أ.د. علي محمد الخوري
خلال السنوات الماضية، تصاعدت التكلفة البشرية والاقتصادية للعمليات والاشتباكات العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة، جعلت من الحروب قوة هيكلية تقضّ مضاجع الاقتصادات العالمية، وتُنذر بانهيار ما تبقى من مقومات الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في المناطق والبلدان المتأثرة، خاصة تلك التي أوشكت ركائز صمودها على النفاد. في ظل هذا الواقع، يدخل العالم مرحلة جديدة من الحروب المُمتدة، التي تتداخل فيها المصالح السياسية مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بصورةٍ مُركّبة، وتمتدُّ آثارها إلى أبعد بكثير من ساحات القتال المباشرة. المسألة الأبرز تكمن في أن هذه الأزمات قد أفضت لقيام نظام دولي يكتنفه الغموض وعدم اليقين الاقتصادي والاستراتيجي، بعدما أصبحت الحروب والمواجهات المسلحة حقيقة هيكلية في بنية الاقتصاد العالمي، مُلقيةً بظلالها على فرص التنمية، ومهيئةً العالم لمرحلة جديدة من المخاطر والتقلبات الاقتصادية. الأعباء الاقتصادية غير المسبوقة تؤكد الأرقام والإحصاءات الصادرة عن مؤشر السلام العالمي إلى أن الكلفة الاقتصادية للعنف (Economic Cost of Violence) بلغت في عام 2024 نحو 20 تريليون دولار، وهو ما يُمثل أكثر من 11% من إجمالي الناتج العالمي، ليعكس بوضوح عجز النظام الدولي الراهن عن احتواء الصراعات والتعامل مع الأزمات الأمنية المُعقدة. بمنظور أوسع، التداعيات الاقتصادية تتجاوز مفهوم الاضطرابات المناطقية المحدودة إلى تهديد البنية الأساسية للاقتصاد العالمي بأسره.
فالنزاعات التي اندلعت في مناطق استراتيجية حيوية مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز، أدّت إلى اضطرابات واسعة في حركة الطاقة ومسارات التجارة الدولية، الأمر الذي تسبّب في ارتفاعٍات كبيرة في تكاليف الشحن البحري، مُضاعفاً الأعباء الاقتصادية القائمة. وكنتيجةً طبيعية لذلك، ظهرت موجاتٌ متتالية من «التضخم المركّب»، وهو مزيج خطِر من الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار في آن واحد، بات يُهدد استقرار الاقتصادات المتقدمة والنامية معًا.
استمرارية المواجهات العسكرية وتحوّلها إلى ظواهر مُتكررة يُشير إلى تحوّل الصراعات من كونها حالات مؤقتة إلى واقع بنيوي دائم، تتحرك فيها عجلة الحرب كقوة فاعلة، وتُعيد تشكيل العلاقات الدولية، وتؤثر مباشرةً في مسارات الاقتصاد العالمي وإعادة تشكليه بصفة مُستمرة. الحروب كاقتصاد سياسي جديد هذا الواقع يعيد التأكيد على ما ذهب إليه المُفكّر الاستراتيجي كارل فون كلاوزفيتز، أحد أبرز المنظّرين العسكريين في التاريخ الحديث، حين وصف الحرب بأنها «امتدادٌ للسياسة بوسائل أخرى»، قاصدًا بذلك أنّ الحروب في حقيقتها ليست بأحداث منفصلة أو أهداف قائمة بذاتها، بل وسائل سياسية تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية حين تفشل الخيارات الدبلوماسية والتفاوضية.
غير أن العالم اليوم يشهد واقعًا يتجاوز بكثير هذا التصور الكلاسيكي، الذي قدمه كلاوزفيتز قبل قرنين من الزمن ليجد اليوم مصداقية أعمق، إذ لم تعد الحروب وسائل تُستخدم في ظروفٍ خاصة، بل تحوّلت إلى جوهر السياسة نفسها، وإلى المحرّك الأساسي للاقتصاد والعلاقات الدولية، وإلى قوة بنيوية دائمة تعيد صياغة منظومة المصالح والتوازنات الدولية بصورة مستمرة، ليجعل من الحروب في عصرنا الحالي واقعًا استراتيجيًا يتغلغل في قلب السياسة العالمية، وليس مجرد أدوات مُكملة لها. المأساة الإنسانية لا يمكن قراءة المعطيات الاقتصادية الحالية بمعزل عن المشهد الإنساني المؤلم الذي يرافقها، فقد سجّل العالم في العام الماضي مقتل أكثر من 152 ألف شخص، وهو الرقم الأعلى الذي يُسجَّل في عامٍ واحد منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي موازاة ذلك، يعيش أكثر من 120 مليون شخص في أوضاعٍ قاسية كلاجئين أو نازحين داخلياً، الأمر الذي يجعل أزمة النزوح العالمي تتحوّل إلى مأساة إنسانية طويلة الأمد، وتُسهم في مفاقمة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الدول المستقبلة، وتضغط بشكل كبير على مواردها، وتُهدّد قدرتها على حماية وحدتها الاجتماعية واستقرارها الداخلي. وتزداد خطورة هذه الأوضاع الإنسانية مع استمرار المواجهات المُسلحة واشتداد الضغوط الاقتصادية الناجمة عنها. فلم تعد التداعيات محصورة في تهديد الأرواح البشرية، بل تمتد آثارها لتقويض الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول والمناطق المتأثرة، خاصةً تلك التي لم تعد تملك سوى الحد الأدنى من مقومات الصمود والبقاء.
الاقتصاد العالمي تحت وطأة العسكرة إذا وسّعنا عدسة النظر لفهم ما يجري، فإن انعكاسات الصراعات المُسلّحة على الاقتصاد العالمي تتجاوز الأبعاد التقليدية من خسائر بشرية ومادية مباشرة إلى إعادة تشكيل هيكل النظام الاقتصادي العالمي بأكمله. فارتفاع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة تقارب 10% في عام واحد، إلى ما يزيد على 2.7 تريليون دولار، يكشف عن إعادة توجيه هائلة للموارد العالمية من قطاعات التنمية المستدامة، مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، نحو صناعة الحرب واقتصاديات الأمن، ليُعيد صياغة العلاقات الاقتصادية بين الدول ويخلق حلقات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.
على المستوى الإقليمي، تبرز أوروبا كمثال واضحٍ على الثمن الاقتصادي الكبير للحروب المُمتدة. فقد تصاعد الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 17%، ليصل إلى نحو 700 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الباردة، مدفوعاً بشكل رئيسي بالحرب الجارية في أوكرانيا وتصاعد التوتر الجيوسياسي مع روسيا.
وبالتزامن مع ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط أيضًا مستويات قياسية جديدة في الإنفاق العسكري، لتصل إلى243 مليار دولار في عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً قدره15% مقارنة بعام 2023. وقد وسّعت دول الخليج العربي، استثماراتها العسكرية عبر صفقات بلغت قيمتها حوالي 142 مليار دولار، شملت مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأمنية الحديثة. تُظهر هذه الأرقام بوضوح ملامح نظام عالمي جديد تتزايد فيه العسكرة، وتعكس توجه الحكومات للاستثمار الاستراتيجي في التسلح كإجراء احتياطي ووقائي تحسبًا للتقلبات والتوترات المحتملة على المستوى الإقليمي والدولي.
لكن هذه الخطوة تُعَدّ، رغم دوافعها الوقائية، مؤشراً خطيراً على تراجع الاهتمام بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأجندات الوطنية، في ظل سياق دولي معقّد تتداخل فيه المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية. كيف تُستغل الأزمات لخلق فرص اقتصادية جديدة تتضح هنا الأطروحة السياسية-الاقتصادية المتمثلة في «نظرية الصدمة» (Shock Doctrine)، التي تشير إلى استغلال بعض القوى لحالات الحروب والأزمات الكبرى لإرباك المجتمعات ومن أجل فرض تغييرات اقتصادية وسياسية يصعب قبولها في الأوقات الاعتيادية مثل تحرير الأسواق أو خصخصة الأصول العامة أو إعادة تشكيل النظام الاجتماعي لصالح فئات معينة، وبين مفهوم «الاقتصاد السياسي للصراع» (Political Economy of Conflict)، الذي يبرز كيف أن الصراعات والحروب أصبحت اليوم أدوات استراتيجية مقصودة لإعادة تشكيل الاقتصادات المحلية وتوزيع النفوذ والسيطرة على الموارد الاقتصادية والسياسية بين القوى الدولية. ما تنوه إليه الدراسات النقدية في الاقتصاد السياسي هو أن الحروب أصبحت تدار لتكون بمثابة «الصدمة» التي تفتح الباب أمام التحولات.
وإذا انتقلنا إلى الدول التي تفتقر إلى الاستقرار اليوم، مثل أوكرانيا وغزة وغيرها من المناطق التي تشهد بؤراً مُلتهبة للصراع، سيتّضح لنا بجلاء كيف أصبحت هذه المناطق بمنزلة مختبرات حيّة لاختبار قدرة النظام العالمي على احتواء الأزمات الكبرى والتعامل معها. فأوكرانيا اليوم تواجه فاتورةً لإعادة الإعمار تُقدَّر بنحو ثلاثة أضعاف حجم اقتصادها السنوي، الأمر الذي يجعلها في حالة اعتماد مستمر على الدعم الخارجي، في حين يعاني قطاع غزة انهياراً اقتصادياً شبه كامل، مع ارتفاع معدلات البطالة فيه إلى مستويات قياسية فاقت 90%، ليجعله عاجزًا عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات التنمية أو حتى التعافي الاقتصادي. ولتفسير هذه الحالة بشكل أوضح، تبدو نظرية الاقتصادي البارز بول كولير التي طرحها في كتابه «مصيدة القاع» أو «مليار القاع»(The Bottom Billion) ذات دلالة عميقة، لكيفية احتجاز المجتمعات والاقتصادات في «مصائد». فكرة النظرية قائمة على حقيقة أن ما يقارب مليار شخص يعيشون في نحو 60 دولة عاجزة عن تحقيق النمو الاقتصادي رغم جهود التنمية العالمية.
ويرى كولير أنّ الدول التي تغرق في دوامة النزاعات والصراعات المسلحة لا تفقد مواردها وفرصها الاقتصادية على المدى القصير فقط، بل تصبح محاصرة داخل حلقات مُفرغة من التراجع الاقتصادي المستمر، والاعتماد المتزايد على المساعدات الخارجية والقروض الدولية، وليؤدي ذلك إلى مزيد من الفقر والتبعية، ويرسّخ من ضعف المؤسسات الداخلية ويمنع قيام بيئة تنموية حقيقية. وتؤكد تجربة كلّ من أوكرانيا وغزة أنّ الخروج من هذه الحلقات المُغلقة ليس أمراً يسيراً أو ممكنًا بالمساعدات الطارئة، بل يتطلّب تدخلاً دولياً طويل الأمد وإصلاحاتٍ عميقة في بُنية المؤسسات، بهدف كسر «المصيدة» وإعادة دمج هذه الدول في الاقتصاد العالمي بصورة فاعلة ومستدامة.
التكلفة البيئية على صعيد آخر، الأزمة البيئية التي تنتج عن النزاعات المسلحة تمثّل تحدياً لا يقل خطورة عن التكلفة الاقتصادية المباشرة، فتدمير الأنظمة البيئية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلات أخرى أكثر عمقاً وتعقيداً، مثل الأزمات الاقتصادية الخانقة، واشتداد المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والتهجير، وتصاعد الاحتقان السياسي بين الأنظمة الحاكمة والمجتمعات. لذلك، فإن التعامل مع الأزمة البيئية يقتضي نظرةً أوسع وأكثر شمولاً، تدرك جيداً مدى الترابط والتداخل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وبحسب دراسة من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة بلغت الأضرار البيئية للصراع في أوكرانيا وحدها نحو56.4 مليار دولار حتى عام 2024. كما تشير البيانات إلى أن النزاعات المسلحة مسؤولة عن نحو 5.5% من إجمالي الانبعاثات العالمية للكربون، وأن حرب غزة حتى يناير 2025 ولّدت انبعاثات تُقدر بنحو 31 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
هذه المعطيات تؤكد مرة أخرى بأن الحلول الجزئية أو المؤقتة لن تكون كافية لمعالجة جذور الأزمات المتفاقمة في العالم اليوم. السلام كمرتكز للتنمية الاقتصادية إزاء هذه التحديات الكبرى التي تهزّ دعائم النظام العالمي، وتُهدد بنسف قواعد الاستقرار والتنمية التي بُنيت على مدى عقود، بات على متخذي القرار، ولا سيما في العالم العربي، إعادة قراءة مفهوم السلام من منظورٍ جديد، يتجاوز التعريف التقليدي الضيق الذي يحصر السلام في غياب الحروب.
ومن أجل تحقيق هذه النقلة الضرورية، فإنّ مفهوم السلام المُعاصر يجب أن يتحول أولاً إلى أولوية استراتيجية مركزية، تُصاغ وفق رؤية سياسية واقتصادية غير تقليدية، وتؤسّس لمنهج وقائي طويل الأمد، وتستند إلى النظريات الحديثة في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، بحيث يكون السلام مرتكزًا بنيويًا في عملية التنمية الاقتصادية، لا مجرد غاية أمنية أو أخلاقية. اقتصاد الحروب ومصيدة الصراع ولابد من الوعي والاستفادة من التجارب التاريخية، التي تؤكد أن المجتمعات التي تُهيمن عليها النزاعات المسلحة تفقد تدريجياً قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وتتحول إلى رهينة لما يُعرف في نظريات الاقتصاد السياسي الحديثة ب«اقتصاد الحرب»، حيث تُوجَّه الموارد والإمكانات نحو تغذية الصراعات بدلًا من الاستثمار في التنمية والبناء. وأن هذا الواقع لا يُنتج سوى حلقات متعاقبة من الفقر والعجز المزمن عن تحقيق التنمية المستدامة. القوة الناعمة أمام هذا المشهد، فإن الدول العربية مُطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تترجم مفهوم السلام إلى أطر وسياسات عملية تتخطى المألوف السياسي التقليدي. ويتعين أن تستند هذه السياسات إلى مبدأ «الوقائية الاستراتيجية»، من خلال توظيف أنظمة الرصد والتنبؤ المبكّر، واعتماد الاستراتيجيات الدبلوماسية الاستباقية، وتقوية المؤسسات الإقليمية والعربية المعنية بحلّ النزاعات وتسويتها قبل اشتعالها أو توسعها، وهو نهج يُترجم بوضوح نظرية «القوة الناعمة»، التي تؤكد على فعالية الأدوات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية في حل الخلافات الدولية بصورة أكثر جدوى مقارنة بالوسائل العسكرية التقليدية. الدولة التنموية في سياقٍ متصل، تحتاج الدول العربية إلى إعادة هيكلة منظوماتها الاقتصادية الوطنية وفق مفهوم «الدولة التنموية»، وهو المفهوم الذي يضع الدولة في موقع المبادرة الفاعلة لقيادة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال سياسات اقتصادية تجمع بين الحوكمة والإدارة المسؤولة، وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع مستوى الإنتاجية الوطنية. هذا النهج يمنح الدول فرصةً لاستعادة الروابط بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وإعادة ترميم الثقة الاجتماعية التي تُعد حجر الزاوية لأي مشروع نهضوي حقيقي.

كما أنّه يُهيّئ لهذه الدول إمكانية التحرّر التدريجي من حالة الاعتمادية والتبعية الاقتصادية والسياسية المزمنة، ويتيح لها امتلاك زمام المبادرة الوطنية في صياغة مستقبلها الاقتصادي والسياسي بعيداً عن دائرة النفوذ الخارجي. الاقتصاد البيئي من المهم، في سياق هذا التصور الشامل، أن يكون البناء المؤسساتي للدول التي تعاني من آثار النزاعات والصراعات الداخلية مترافقاً مع نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الأزمات البيئية التي تسببها تلك النزاعات. وهنا يجب على صانع القرار في العالم العربي أن يتبنى مقاربة «الاقتصاد البيئي» بمنظوره المعاصر، والذي يفرض إدراج الموارد الطبيعية والبيئية كعنصر أساسي ضمن الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فقد أثبتت تجربة الصراعات المعاصرة، أن البيئة أصبحت ضحية مباشرة للحروب، وأن الدمار البيئي بات يفرض كلفة اقتصادية باهظة تقوضّ آفاق التنمية المستقبلية. لذلك فإن تصميم ميزانيات وخطط إعادة الإعمار يجب أن يتضمن البُعد البيئي، بحيث يُعاد بناء رأس المال الطبيعي كجزء من إعادة بناء رأس المال البشري والاجتماعي. صناديق الاستثمار التنموية على المستوى التطبيقي والعملي، يتعيّن أن تتبلور توصيات السياسات الموجهة لصانعي القرار في العالم العربي في صورة مبادرات استراتيجية وملموسة. ومن ذلك مثلاً، إنشاء صناديق إقليمية مشتركة تُخصَّص حصرياً للاستثمار في السلام والتنمية المستدامة، وتُمول من خلال تحويل نسبة مدروسة من الإنفاق العسكري نحو دعم القطاعات الحيوية كالتعليم والتكنولوجيا والابتكار وتمكين الشباب.
ومن شأن مثل هذه الصناديق أن تُساهم في بناء مجتمعات عربية أكثر مناعةً ومرونةً اقتصادياً واجتماعياً، وأكثر قدرةً على التعامل الفعال مع التحديات والأزمات الداخلية والخارجية، وتؤسس لمنظومة إقليمية مستقرة وفاعلة ضمن المشهد الدولي المعاصر. التحالفات التنموية الوقائية أما على المستوى الدبلوماسي، فإن الدول العربية مُطالبة بإعادة صياغة مفهوم «التحالفات الإقليمية» من منظور استراتيجي يتجاوز الأطر التقليدية التي حصرت العلاقات بين الدول في خانة التنافس أو المواجهة أو الاصطفافات الضيقة التي تخدم مصالح مؤقتة.
هذه التحالفات التي يمكن تسميتها ب «التحالفات التنموية الوقائية» يجب أن تؤسس لبناء فضاءات جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي طويل الأجل، مثل البنية التحتية المشتركة، والتكامل الاقتصادي، والتبادل التجاري، بدلًا من مجرد تحالفات مؤقتة تستند إلى توازنات أو مواقف سياسية آنية. كذلك، يجب أن تقوم هذه الشراكات الجديدة على قواعد المصالح الواقعية والمنافع المتبادلة بين الدول، بعيدًا عن لغة الشعارات أو الخطابات السياسية التقليدية التي لم تعد تلبي احتياجات المرحلة.
المستقبل العربي إيجازاً، العالم العربي يقف عند حافة تاريخية وأمامه خياران، إما البقاء في ظلال أزمات الماضي التي لن تنتهي وإما الانطلاق نحو صناعة مستقبلٍ يتسم بالأمل والبناء. السلام الحقيقي الذي تنشده الشعوب العربية لن يُبنى بغياب الحروب، وإنما ببناء الإنسان والنهوض بالمجتمع، وإعلاء الكرامة الإنسانية كركيزة للتنمية، وهو ما يتطلب الجرأة والإرادة لكسر الحلقات المفرغة التي تربط بين الحرب والاقتصاد. تلك هي الدول وحدها التي ستتمكن من رسم معالم مستقبلها، وتحديد موقعها ودورها ضمن النظام العالمي الجديد.