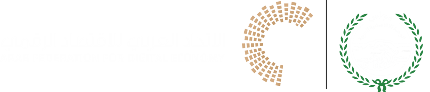في مقابلة لسعادة د. علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، لصحيفة “إرم نيوز”:
س: كيف ترى واقع الاقتصاد الرقمي في العالم العربي اليوم؟ وهل نحن نسير في الاتجاه الصحيح؟
أرى أن الاقتصاد الرقمي في العالم العربي يشهد تطورًا ملموسًا ولكنه متفاوت بين دولة وأخرى. العديد من الحكومات العربية تبنّت استراتيجيات طموحة للتحول الرقمي وأطلقت مبادرات في مجالات الحكومة الإلكترونية والتجارة الرقمية، وهذا أدى إلى نمو ملحوظ في الخدمات الإلكترونية والشركات الناشئة التقنية.
على سبيل المثال، حققت دول الخليج تقدمًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية واعتمدت خططًا وطنية لدعم أسس الاقتصاد المعرفي. ويُظهر تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي أن الاقتصاد الرقمي قد يصل لحوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بحلول 2030، ما يعادل تقريبًا 900 مليار دولار، وهو ما يظهر حجم الفرصة الاقتصادية المتاحة.
ومع ذلك، لا تزال الفجوة الرقمية قائمة؛ فبعض الدول العربية الأقل دخلًا أو المتأثرة بالنزاعات متأخرة في هذا المضمار. ولكن إجمالًا، الاتجاه الحالي إيجابي ونحو المسار الصحيح من حيث الإدراك المتنامي بأهمية الاقتصاد الرقمي ووضعه ضمن أولويات التنمية، لكن ما زالت هناك حاجة ماسة لتسريع وتيرة التنفيذ بشكل أكثر تكاملًا وشمولية، والاستثمار المستمر والممنهج في البنية الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية، وتبني منظومة إقليمية متكاملة لضمان استفادة جميع الدول العربية من هذا التحول.
س: ما أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في التحول الرقمي، خصوصًا على مستوى التشريعات والبنية التحتية؟
بالرغم من التقدم في مشاريع التحول الرقمي، تواجه الدول العربية جملة من التحديات البنيوية والتشريعية. وأبرز هذه التحديات تشمل:
- قصور التشريعات والسياسات الرقمية: تفتقر كثير من الدول إلى أطر قانونية محدثة تنظم الاقتصاد الرقمي بشكل متكامل، سواء فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية أو بحماية البيانات والأمن السيبراني. هذا القصور التشريعي يجعل التحول الرقمي يتم أحيانًا في فراغ قانوني أو وفق قوانين قديمة غير ملائمة.
- نقص الكوادر والمهارات الرقمية: يبرز أيضًا تحدي الفجوة في المهارات؛ إذ تعاني الأسواق العربية من نقص المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما يصعّب على القطاعين العام والخاص مواكبة التحول الرقمي.
- البنية التحتية الرقمية الضعيفة في بعض الدول: لا يزال الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وخدمات الاتصال الحديثة غير متكافئ في المنطقة. تعاني دول عديدة من نقص في شبكات النطاق العريض وتفاوت في انتشار تقنيات الجيل الخامس، مما يعيق توسع وانتشار الخدمات الرقمية.
- الكلفة التقنية وضعف الاستثمار: تتطلب البنية التحتية الرقمية الحديثة والتقنيات المبتكرة والناشئة استثمارات ضخمة. قد تواجه الدول محدودة الموارد صعوبة في تحمل تكاليف التحول الرقمي الشامل، كما أن العائد على الاستثمار يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى والتي قد تصطدم بأولويات تنموية أخرى أكثر إلحاحًا.
لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على الدول العربية تحديث تشريعاتها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة – مثل سنّ القوانين الوطنية لحماية البيانات والمعاملات الرقمية – وكذلك رصد ميزانيات كافية لتطوير البنية التحتية الرقمية خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية. علاوة على ذلك، لا بد من الاستثمار في التعليم والتدريب لسد الفجوة المهارية، فضلًا عن رفع مستوى التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات ووضع معايير تنظيمية موحدة تدعم إنشاء سوق رقمية عربية مشتركة.
س: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟تلعب البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي دورًا جوهريًا في إحداث نقلة نوعية واستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمن خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، تستطيع الحكومات والشركات اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، لتسهم في تحسين كفاءة الخدمات وجودة الأداء، وخفض التكاليف، وتخصيص الموارد المالية والاستثمارات للمجالات ذات الأولوية.
على سبيل المثال، كثير من الدول العربية، أبرزها الإمارات والسعودية، بدأت في توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي، في تحليل البيانات السكانية والاقتصادية بهدف تحسين دقة التخطيط التنموي ورفع مستوى كفاءة الخدمات.
من المهم أيضاً أن نلفت إلى مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية مختلف القطاعات؛ في الزراعة يمكن توظيفه لتحسين المحاصيل من خلال تحليل أنماط الطقس والتربة، وفي القطاع الصحي في تشخيص الأمراض مبكرًا وتحسين خدمات رعاية المرضى، وفي التعليم في دعم التعليم الذكي المتكيّف مع قدرات الطلبة.
أما اقتصاديًا، فالذكاء الاصطناعي هو محرّك للابتكار وأداة لخلق فرص عمل نوعية في مجالات جديدة. وبحسب تقارير الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يُقدر أن يسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 300 مليار في الناتج الإجمالي للدول العربية خلال العقد الحالي، نصفها ستكون من نصيب الدول الخليجية التي بدأت تستثمر بجرأة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، ومنها تجربة الإمارات في إنشاء مجمع بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ليكون الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، توفر التقنيات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي حلولًا لتحديات اجتماعية مثل تحسين السلامة المرورية عبر أنظمة المواصلات الذكية، ومواجهة الأزمات الصحية من خلال نماذج التنبؤ وانتشار الأمراض والأوبئة.
باختصار، البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي أصبحا بمثابة الوقود الجديد للاقتصاد العالمي وممكنًا لتحقيق التنمية المستدامة، بشرط توفر بنية تحتية رقمية ملائمة وتشريعات تضمن خصوصية البيانات وأخلاقيات استخدامها.
س: كيف ترى العلاقة بين الأمن القومي والاقتصاد الرقمي؟ وهل هناك تهديدات تستدعي استراتيجيات جديدة؟بات الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي في العصر الحديث. فمع اعتماد الدول المتزايد على التكنولوجيا في إدارة البنية التحتية الحيوية (كالطاقة والمياه والنقل والقطاع المالي)، أصبح تأمين الفضاءات السيبرانية جزءًا محورياً في تأمين المنظومة الوطنية ككل. إذ أن أي خلل أو هجوم إلكتروني على أنظمة مثل المصارف أو شبكات الكهرباء قد يشلّ الاقتصاد ويهدد استقرار الدولة. ومن هنا، تتكامل العلاقة بين الأمن القومي والاقتصاد الرقمي؛ فالتوسع في الاقتصاد الرقمي يتطلب فضاءً إلكترونيًا مستقرًا وآمنًا، بينما قد يؤدي هذا التوسع ذاته إلى زيادة الانكشاف على تهديدات سيبرانية جديدة تستوجب استراتيجيات دفاعية متطورة وأكثر استباقية.
هناك بالفعل تهديدات رقمية متصاعدة تستدعي تبني استراتيجيات جديدة. من أبرز هذه التهديدات الهجمات السيبرانية المتطورة التي تنفذها جهات خارجة عن القانون أو حتى تلك التي قد ترعاها دول، والتي تستغل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لاختراق الأنظمة الإلكترونية.
كما برزت في الآونة الأخيرة مخاطر متعلقة بسيادة البيانات وخصوصيتها؛ فالتحول الرقمي أفرز كمًا هائلًا من البيانات الحساسة، واستغلال هذه البيانات أو وقوعها في الأيدي الخطأ يشكل خطرًا أمنيًا.
أيضًا، يعتمد الاقتصاد الرقمي العربي على الكثير من التقنيات المستوردة والبنية التحتية العالمية (مثل أنظمة الحوسبة السحابية الأجنبية)، وهو ما يفتح احتمالية التعرض لنقاط ضغط خارجية أو برمجيات ضارة مدسوسة.
وقد بلغت الخسائر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2024، ويُتوقّع ارتفاعها إلى أكثر من 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول 2025. عربيًا، شهدت المنطقة تضاعفًا في عدد الهجمات السيبرانية الناجحة خلال عام واحد (2023–2024)، فيما يعد قطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية والقطاع الحكومي الأكثر استهدافًا، خصوصًا في الخليج. ووفق التقارير، فإن متوسط الأضرار المالية للهجمات في الشرق الأوسط يزيد بحوالي الضعف عن المعدل العالمي، بسبب الطبيعة المركزة والمتطورة للهجمات في المنطقة.
في ظل هذه المعطيات، تعمل الدول حاليًا على صياغة استجابات استراتيجية مثل إنشاء هيئات متخصصة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، ووضع أطر سياسات لحماية البنية التحتية الحرجة، وتطوير نظم تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الهجمات الإلكترونية بشكل استباقي.
الخلاصة هي أن أمن الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة ملحّة ومكون رئيسي في منظومة الأمن القومي، ويتطلب ذلك استراتيجيات جديدة تشمل تحديث التشريعات، وتأهيل الكوادر المتخصصة، والاستثمار في الحلول التأمينية المتطورة، بالإضافة إلى مستوى جديد من التعاون الدولي والإقليمي لدرء المخاطر العابرة للحدود.
س: باعتبارك ترأس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.. ما هي أبرز المبادرات التي تعملون عليها حاليًا لدعم الاقتصادات العربية؟نحن في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي نركز على دعم المبادرات الاستراتيجية العربية الشاملة التي تهدف إلى تمكين الاقتصادات العربية من اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي وبناء مستقبل تنموي متصل. من أبرز ما نعمل عليه:
- الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2030: تم تطوير هذه الرؤية بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل جامعة هارفرد والأمم المتحدة والبنك الدولي وبمشاركة أكثر من 120 خبير عالمي، وتم اعتمادها في القادة العرب عام 2022. ونقوم حالياً بتحديث وتنفيذ الرؤية لتشمل كافة أبعاد التحول الرقمي العربي، وستتضمن مخطوطات تفصيلية لتدعيم التكامل الرقمي بين الدول العربية ورفع تنافسية الاقتصاد الرقمي الإقليمية والعالمية. الهدف من هذه الرؤية هو بناء اقتصادات رقمية مترابطة وأكثر استدامة، عبر توحيد المعايير التقنية وتنمية البنية التحتية المشتركة.
- إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة: يعمل الاتحاد على عدد من المشاريع التطبيقية التي تخدم التحول الرقمي العربي، مثل المنصة العربية للتعليم والتدريب الإلكتروني “مسارات” لتأهيل الكفاءات الرقمية الشابة، والمنصة العربية للغذاء لرقمنة سلاسل الإمداد الزراعي ودعم الأمن الغذائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. كما أن الاتحاد يدعم حاضنات الابتكار الرقمي في دول مختلفة لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التقنيات المتقدمة.
- المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي: طورنا في الاتحاد مؤشر لقياس الأداء الرقمي في الدول العربية يصدر كل عامين، وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في كل بلد وتحفيز صانعي القرار على تبني السياسات المناسبة. هذا المؤشر يوفر بيانات موضوعية تساعد على توجيه الاستثمارات والإصلاحات في المجالات الرقمية الأكثر احتياجًا.
- الشراكات الدولية والاستثمارات: ندرك أهمية الانفتاح على تجارب وخبرات الدول المتقدمة. لذا عقدنا مؤخراً شراكة استراتيجية مع الصين في مجال الاقتصاد الرقمي، بهدف نقل التكنولوجيا والمعرفة وجذب الاستثمارات الصينية لدعم البنية التحتية والمشاريع الرقمية العربية. ونبحث أيضًا توسيع الشراكات مع منظمات دولية وشركات عالمية لتكوين شبكة دعم دولية للاقتصاد الرقمي العربي.
- إقامة المنتديات وبرامج بناء القدرات: الاتحاد شريك رئيسي في تنظيم المؤتمرات الدولية بالتعاون مع القطاع العام والخاص، ونجح في تنظيم أكثر من 27 مؤتمر دولي في السنوات الخمس الماضية، وجذب ما يقرب من 260 ألف مشارك من 190 دولة. كما ويحرص على تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لمساعدة الحكومات العربية على صياغة سياسات رقمية فعالة وتبادل أفضل الممارسات.
باختصار، ترتكز جهود الاتحاد على تمكين الدول العربية رقمياً عبر وضع رؤية موحدة وتنفيذ مبادرات عملية تغطي جوانب السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وبناء الكوادر المؤهلة، وجذب الاستثمارات، بما يضمن أن دخولنا عصر الاقتصاد الرقمي سيكون عامل دفع للتنمية الشاملة في العالم العربي.
هل لديكم تقديرات لحجم المكاسب الاقتصادية التي ققتها أو قد تحققها الدول العربية بسبب التحول الرقمي؟
يحمل التحول الرقمي ه إمكانات اقتصادية هائلة للدول العربية، وتشير دراسات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بأن الاقتصاد الرقمي يساهم حاليًا بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية، ومن المتوقع، أن ترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 15% بحلول عام 2030، أي ما يعادل 900 مليار دولار.
على مستوى البنية التحتية، تُظهر التحليلات أن زيادة انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة (النطاق العريض) بنسبة 10% من شأنها أن تؤدي إلى نمو الناتج المحلي للفرد بنحو 0.71% في الدول العربية. وإذا أخذنا عدد سكان المنطقة العربية (456 مليون نسمة) بعين الاعتبار، فإن ذلك يترجم إلى إضافة سنوية تبلغ نحو 24 مليار دولار للاقتصاد الإقليمي.
ويُعتبر قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات الواعدة؛ إذ تجاوزت قيمته في دول مجلس التعاون الخليجي 76 مليار دولار، فيما وصل حجمه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نحو 135 مليار دولار، مع توقعات بتضاعف قيمته إلى 264 مليار دولار بحلول 2029. فضلًا عن ذلك، استراتيجيات التحول الرقمي في المنطقة من شأنها أن تدعم مزيد من التحسين في كفاءة الخدمات الحكومية وخفض الإنفاق، كما في استراتيجية الإمارات للبلوك تشين، التي تستهدف على سبيل المثال توفير نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
ما حجم الفرص التي يمكن جنيها من إنشاء سوق رقمية عربية مشتركة؟
إنشاء سوق رقمية عربية مشتركة يفتح آفاق واسعة للنمو والتكامل الاقتصادي، ويعالج العديد من التحديات التي واجهت محاولات التكامل السابقة، خاصة مع تدني مستويات التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز اليوم 10% مقارنة بـ66% في الاتحاد الأوروبي.
المنصات الرقمية المشتركة، يمكنها تنشيط التجارة وتحفيز المنتجين العرب، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة، ورفع قدراتهم للوصول إلى ملايين المستهلكين العرب. كما أن المنافسة المفتوحة في هذه المنصات ستؤدي إلى خفض الأسعار وتقليل معدلات التضخم نتيجة انخفاض الأعباء التشغيلية.
المنصات الرقمية المشتركة من شأنها تنشيط التجارة وزيادة رواج المنتجات العربية، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، وتحفيز المنتجين والمصنعين على توسيع إنتاجهم والوصول إلى ملايين المستهلكين في المنطقة.
كما ستؤدي المنافسة المفتوحة عبر هذه المنصات إلى خفض أسعار السلع وتقليل معدلات التضخم، نتيجة انخفاض التكاليف التشغيلية والرأسمالية. ومن شأن السوق المشتركة أن تدعم نمو الشركات وتجارة الأعمال (B2B)، وترفع كفاءة سلاسل التوريد وتكامل القطاعات الاقتصادية. وسيقود توسع التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات جديدة كالدعم التقني، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات والخدمات اللوجستية.
من جهة أخرى، الحلول التكنولوجية تتيح تخطي العقبات البيروقراطية التي أعاقت تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية لعقود، مثل إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وتتبع المنتجات بشفافية.
هناك فرصة حقيقية كبيرة للسوق الرقمية العربية المشتركة، وتشير توقعاتنا إلى أنها قد تستقطب استثمارات كبيرة من صناديق الاستثمار ورجال الأعمال العرب، إذ يمكن أن تشكل هذه السوق بيئة جاذبة لاستعادة جزء كبير من رؤوس الأموال العربية التي تستثمر حالياً خارج المنطقة، والتي تُقدّر بأكثر من 1.5 تريليون دولار. وجود منصات رقمية عربية مشتركة واسعة النطاق، مع سهولة الوصول لملايين المستهلكين العرب، قد يشجع المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو هذه السوق الواعدة وهو ما سيدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية بصورة مباشرة.
ما نسبة الشباب العربي المؤهل رقميًا اليوم مقارنة باحتياجات سوق العمل الرقمية؟ وهل هناك دراسات أو بيانات تدعم ذلك؟
يمثل الشباب العربي المحرك الأساسي للتحول الرقمي، لكن هناك فجوة واضحة بين المهارات الرقمية التي يمتلكونها وبين متطلبات سوق العمل المتغيرة.
فبينما تتراوح نسبة الشباب الذين يمتلكون المهارات الرقمية في المنطقة العربية بين 40% إلى 50%، إلا أن أكثر من 35% منهم يفتقرون إلى المهارات الرقمية المتقدمة التي يحتاجها سوق العمل في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
المقلق هو أنه وبحلول عام 2040، سيدخل حوالي 127 مليون شاب عربي سوق العمل، وسيكون من الضروري تزويدهم بمهارات تواكب التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والتقنيات المناخية.
وتتعمق هذه المشكلة مع ضعف منظومات التعليم الحالية، حيث لا زالت المناهج التعليمية غير متوافقة بشكل كاف مع متطلبات وظائف المستقبل، وهو الأمر الذي يتضح في ارتفاع نسب البطالة بين خريجي الجامعات العرب اليوم إلى نحو 40%، فيما تجاوز معدل بطالة الشباب في المنطقة ككل 24%، وهو ضعف المعدل العالمي.
عامةً، هناك نقص في التخصصات التقنية، إذ لا تتجاوز نسبة الخريجين من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 13%، وهو ما يشكّل تحدياً كبيراً في ظل الطلب المتزايد على هذه التخصصات في سوق العمل.
س: انطلاقًا من طرحكم في كتاب “الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات” الصادر العام الماضي، كيف تُقدّر حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدول نتيجة تجارة وتعاطي المخدرات، خاصة في العالم العربي؟
لقد كشفت هذه الدراسة عن أرقام مقلقة وضخمة لحجم الاقتصاد الموازي المرتبط بالمخدرات وتداعياته السلبية. على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن تجارة المخدرات غير المشروعة تدرّ أكثر من 320 مليار دولار سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات الإجرامية في العالم.
هذه العائدات الضخمة تأتي على حساب خسائر اقتصادية تتكبدها الدول والمجتمعات تفوق ذلك الرقم بعدة أضعاف عند احتساب الأضرار غير المباشرة. فانتشار المخدرات يفرض أعباء مالية هائلة على الحكومات من خلال تكاليف الرعاية الصحية وعلاج الإدمان، وإنفاق ضخم على الأجهزة الأمنية والسجون، ناهيك عن فقدان الإنتاجية بسبب خروج شريحة من القوى العاملة، خصوصًا الشباب، من دائرة النشاط الاقتصادي.
على سبيل المثال، تقدر الدراسات الدولية أن تكلفة تعاطي المخدرات على بعض الاقتصادات المتقدمة تعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر، بل تصل إلى نسب أعلى في أزمات المخدرات الحادة، مثل أزمة الأفيونيات التي كلفت الاقتصاد الأمريكي حوالي 3-4% من الناتج مؤخرًا.
وإذا نقلنا النظر إلى العالم العربي، سنجد أن الخسائر وإن كانت أقل كمّيًا من مثيلاتها في بعض الدول الغربية ذات الاستهلاك العالي، إلا أنها ذات أثر نسبي بالغ على اقتصادات المنطقة. فالدول العربية تتحمل أعباء مكافحة شبكات التهريب الدولي التي تنشط عبر الحدود مستغلة اضطرابات بعض الدول، كما تتحمل كلفة علاج وتأهيل متعاطي المخدرات في نظم صحية تعاني أصلاً من ضغوط متعددة. يضاف إلى ذلك الأثر بعيد المدى للمخدرات في تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف الإنتاجية الوطنية، وعرقلة جهود التنمية البشرية والاقتصادية.
لدينا اليوم في منطقتنا شواهد على تجارة مخدرات مستفحلة كـ “الكبتاجون” التي أصبحت مصدر تمويل للجماعات الإجرامية وتسبب توتّرات أمنية في بعض البلدان، وهذه التجارة يقدّر الخبراء على أنها بمليارات الدولارات سنويًا في الشرق الأوسط. هذه الأموال غير المشروعة تعني موارد مهدورة كان بالإمكان توجيهها للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والمشاريع التنموية.
من هنا يمكن القول إن آفة المخدرات تفرض خسائر مركّبة؛ منها المباشرة كجم الإنفاق والموارد المهدرة، وغير المباشرة كإضعاف رأس المال البشري وتقويض الاستقرار الاجتماعي اللازم للنمو الاقتصادي المستدام.
| أبرز نتائج دراسة المخدرات التي أعدها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي:
· تجارة المخدرات أصبحت تغذي العنف والفساد وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم · الضرر الاقتصادي العالمي للإدمان يتجاوز نصف تريليون دولار سنوياً · 260 مليون من مستخدمي الإنترنت يشاركون في معاملات المخدرات غير المشروعة · 15 % من تجارة المخدرات تتم من خلال الإنترنت · 152 مليون من الشباب أعمارهم بين 18-25 عاماً يتعاطون المخدرات · 50% من المراهقين يميلون للتعاطي عندما يتعرضون للفيديوهات على يوتيوب أو انستجرام · 300 مليون متعاطي حول العالم · أكثر من 70 مليون متعاطي جديد العام الماضي وحده · 105 مليون من النساء يتعاطين المخدرات · ارتفعت حالات إدمان الأدوية، مع انتشار استخدام الأفيونيات في الصناعات الطبية · انتشار واسع للمخدرات الاصطناعية تحت مسميات مثل حبوب الطاقة والتركيز والسعادة! · أكثر من مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية تعود معظمها للإدمان · تجارة المخدرات غير المشروعة تمول 20% من الصراعات المُسلحة في العالم |
س: في رأيك، ما أبرز التحديات التي تواجه السياسات العربية في التعامل مع آفة المخدرات؟
هناك تحديات مُعقدة ومتداخلة تواجه صانعي السياسات في العالم العربي عند التصدي لظاهرة المخدرات، ومن أهمها:
- الطبيعة متعددة الأبعاد للمشكلة: لم تعد المخدرات مجرد قضية جنائية أو صحية منفصلة، بل هي أزمة تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي كما أشارت إليها الدراسة. هذه الطبيعة تستلزم إدراك أعلى من راسمي السياسات العامة بأننا نتعامل مع مُشكلة مُركبة ذات جوانب أمنية وصحية واقتصادية معًا، وهو ما قد يكون غائبًا أحيانًا في التصورات التقليدية التي تحصر المكافحة في الجانب الشرطي أو الضبطي.
- التنسيق الإقليمي والدولي المحدود: تجارة المخدرات بطبيعتها عابرة للحدود، وشبكات التهريب تستغل أي ثغرة بين الدول. يواجه العالم العربي تحديًا في تنسيق جهوده الأمنية والاستخباراتية بين الدول لملاحقة تلك الشبكات. ورغم وجود هيئات مثل مجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بالتعاون الأمني، إلا أن الترجمة العملية لتبادل المعلومات والعمليات المشتركة لا تزال بحاجة إلى التطوير والتكثيف.
- الفساد وغسل الأموال: من التحديات الكبيرة أن تجارة المخدرات غالبًا ما تتغلغل مستفيدة من حالات فساد وضعف الرقابة المالية. قد يتمكن تجار المخدرات من استغلال الأنظمة المصرفية والشركات الوهمية لغسل أرباحهم، وفي حال ضعف التشريعات أو إنفاذها، تتوفر بيئة حاضنة لنمو هذا الاقتصاد الإجرامي. هذا التحدي يتطلب الشفافية والمساءلة العالية في المؤسسات لمواجهته.
- نقص برامج العلاج وإعادة التأهيل: تعطي كثير من السياسات أولوية للعقاب والسجن، بينما تواجه المنطقة ككل نقصًا في البنية التحتية للعلاج من الإدمان وإعادة دمج المتعافين في المجتمع. الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان تجعل الأمر أكثر صعوبة، حيث يتردد المدمن أو أسرته في طلب المساعدة. غياب البرامج العلاجية الشاملة يحوّل مشكلة المخدرات إلى حلقة مفرغة.
- الأوضاع الجيوسياسية المضطربة: تعيش بعض الدول العربية نزاعات أو حالة عدم استقرار (مثل سوريا وبعض مناطق شمال أفريقيا)، وهذه الأوضاع توفر أرضًا خصبة لعصابات المخدرات سواء كمنتجين أو كممرّرين. السياسات العربية تواجه تحدي التعامل مع مصادر المخدرات القادمة من مناطق النزاع هذه، والتي قد لا تكون للحكومات سيطرة كاملة عليها. كذلك يمثل انتشار المخدرات في مناطق النزوح واللاجئين تحديًا خاصًا يتطلب تعاونًا إنسانيًا وأمنيًا معًا.
- الشباب والبطالة: التركيبة السكانية العربية يغلب عليها فئة الشباب، ومع الأسف تستهدف شبكات المخدرات هذه الفئة العمرية مستغلة أحيانًا الفراغ والبطالة. التحدي أمام السياسات يتمثل في تحصين الشباب عبر التوعية والتعليم وفرص العمل، فبدون معالجة عوامل الطلب الداخلية سيبقى خطر انتشار المخدرات قائمًا مهما نجحت الحملات الأمنية في ضبط العرض.
هذه التحديات عامة تتطلب رؤية شمولية في رسم السياسات؛ فلا يمكن الاكتفاء بالحلول الأمنية أو الصحية المنعزلة، بل لا بد من تكامل كافة الجهود الوطنية (التعليمية، والصحية، والتوعوية، والتنموية والاقتصادية) تحت مظلة استراتيجية واحدة لمحاربة المخدرات.
س: ما أهم التوصيات أو الحلول التي طرحتها لمواجهة هذا التهديد المتصاعد؟
أوصت الدراسة بجملة من الحلول المتكاملة لمواجهة آفة المخدرات بشكل أكثر فعالية واستدامة، ومن أبرز تلك التوصيات:
- تبني نهج علاجي ووقائي شامل، بمعنى أنه لا بد من الانتقال من سياسات رد الفعل إلى السياسات الاستباقية. التوصية هنا هي تطوير برامج علاجية وتأهيلية حديثة تستند إلى فهم أدق للجوانب الثقافية والاجتماعية في المجتمعات العربية. قد يشمل ذلك زيادة عدد المراكز العلاجية وتحسين جودتها، وإدماج خدمات الصحة النفسية وبرامج الدعم المجتمعي فيها. كما أنه يجب إعادة تصميم خدمات الرعاية والعلاج وصرف الوصفات الطبية، لضمان منظومة علاجية فعّالة داعمة للتعافي وتمنع إساءة استخدام الأدوية. في الجانب الوقائي، أوصينا بحملات توعية مستدامة موجهة خصوصًا للشباب حول مخاطر المخدرات، تُستخدم فيها وسائل التواصل الحديثة وبمحتوى يتماشى مع ثقافتهم واهتماماتهم.
- تطوير التشريعات وسياسات إنفاذ القانون بصرامة على شبكات الاتجار والمروجين. من الضروري جداً سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها تجار المخدرات، سواء بتشديد العقوبات على جرائم الاتجار أو تحديث القوانين لمواكبة الأنواع الجديدة من المخدرات الصناعية. وفي الوقت نفسه، لا بد من تمييز المتعاطين من ضحايا الإدمان عن تجار المخدرات في المعاملة القانونية، بحيث يوجَّه المتعاطين نحو المصحات العلاجية بدل السجن كلما أمكن. العدالة الإصلاحية في هذا المجال أكثر جدوى وتأثيراً من السياسات العقابية التقليدية. لذا ينبغي أيضاً هنا تحديث السياسات والأنظمة الوطنية لتغيير مفهوم تعاطي المخدرات كسلوك صحي يتطلب العلاج، وليس مجرد العقاب.
- مكافحة الفساد وغسل الأموال. أوصت الدراسة بتكثيف الجهود لملاحقة الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات، وتطوير قدرات وحدات التحريات المالية وتتبع التدفقات المالية المشبوهة العابرة للحدود. وشددت أيضاً على أهمية محاسبة كل من يتواطأ في تسهيل عمل شبكات التهريب، باعتبار أن النزاهة والشفافية في المؤسسات الرسمية تُشكل الركيزة الأساسية في مواجهة هذه الشبكات الإجرامية.
- الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي. التركيز على مزيد من الاستثمار في توظيف التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون، والمراكز العلاجية، لدعم القدرة على التصدي للظاهرة بشكل فعّال. ودعت الدراسة أيضا إلى دعم المراكز البحثية لدراسة ظاهرة المخدرات وأسبابها، وتوجيه السياسات العامة بناء على نتائج هذه الدراسات.
- التعاون الدولي والإقليمي: الحلول المُنعزلة لن تؤتي أُكلها أمام شبكات دولية عابرة للقارات. لذلك دعت الدراسة إلى تفعيل قنوات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الدول العربية من جهة، ومع المنظمات الدولية المتخصصة كمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول من جهة أخرى. وشملت التوصيات إنشاء فرق عمل إقليمية مشتركة تستهدف عصابات التهريب الكبرى، وتوحيد استراتيجيات المكافحة وفق أفضل الممارسات العالمية.
- معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة: أكدت التوصيات أن الحرب على المخدرات لا تُكسب بالمواجهات الأمنية فقط، بل عبر تجفيف المنابع الاجتماعية التي تتغذى عليها الظاهرة. أوصت الدراسة على غرارها بسياسات تنموية تقلص من البطالة والفقر – وهما بيئتان خصبتان لانتشار المخدرات – عبر خلق فرص العمل للشباب وإعادة تأهيل من انزلق منهم في طريق الإدمان ليصبحوا أفرادًا منتجين. كما اقترحت الدراسة إدماج موضوع مكافحة المخدرات ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتشجيع المبادرات المجتمعية، كالمراكز الشبابية والأنشطة الرياضية والثقافية، التي تشغل أوقات الشباب وتبعِدهم عن براثن المخدرات.
بشكل عام، ركزت الحلول المقترحة على التوازن بين آليات العلاج والردع، وبين الدور المحلي على المستوى الوطني والتعاون الدولي، وعلى ابتكار أساليب جديدة بدل الاقتصار على الأساليب التقليدية. الهدف هو تبني نهج أكثر شمولًا وفعالية يجعل مجتمعاتنا العربية أكثر قدرة على صد هذا الخطر المتصاعد وصون مواردها البشرية والاقتصادية.
س: كيف يمكن تعزيز التعاون العربي والدولي للحد من تفشي المخدرات وضمان استدامة التنمية؟
التعاون العربي والدولي عنصر محوري لا غنى عنه في مواجهة أزمة المخدرات، نظرًا للطابع العابر للحدود لهذه الآفة وتشابك آثارها مع مسارات التنمية. لرفع مستوى هذا التعاون، أقترح عدة خطوات أساسية:
أولًا، البناء على الاستراتيجية العربية الموحّدة لمكافحة المخدرات (2023–2028) التي أطلقتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال تطوير آليات التنفيذ العملي. هذه الاستراتيجية يمكن أن تنشئ مراكز عربية تنسيقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات التهريب ومساراتها، لسد الثغرات التي قد تستغلها العصابات بين دولة وأخرى. كما يمكن ضمنها توحيد الأطر القانونية المحلية قدر الإمكان. كما أنه من الأهمية إجراء تقييم دوري لفعالية هذه الاستراتيجية، وتطويرها بشكل مستمر وفق المستجدات والتحديات التي تفرضها أساليب شبكات المخدرات المتغيرة والمتطورة.
ثانيًا، توسيع اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي الدولية. على الصعيد الدولي الأوسع، ينبغي تكثيف الشراكة مع الهيئات الأممية كالأمم المتحدة (مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات) لتدعيم برامج مراقبة الحدود وتبادل الخبرات التقنية في الكشف عن المخدرات. الدعم الفني واللوجستي من الدول المتقدمة سيكون ذا قيمة، سواء في تدريب كوادرنا أو في توفير تكنولوجيا متقدمة للمراقبة والكشف. كذلك من المهم المشاركة النشطة في المبادرات العالمية والإقليمية (مثل عملية الممرات المؤمنة أو غيرها) لضبط حركة تهريب المخدرات عبر البر والبحر.
ثالثًا، التركيز على التنمية المستدامة كخط دفاع وقائي. لا يمكن فصل مكافحة المخدرات عن أجندة التنمية المستدامة. فانتشار المخدرات يقوّض تحقيق أهداف التنمية سواء في الصحة أو التعليم أو الاقتصاد. لذا، لا بد من إدماج سياسات الحد من المخدرات في خطط التنمية الوطنية والإقليمية. على سبيل المثال، ينبغي أن تشمل المؤشرات الإقليمية جهود تقليل نسبة التعاطي وتوسيع العلاج للجميع. أيضًا، يمكن للدول المانحة والمؤسسات الدولية أن تربط بين برامج المساعدات والتنمية في المناطق المتأثرة بزراعة المخدرات أو تجارتها وبين مبادرات لإيجاد بدائل اقتصادية للمجتمعات هناك، حتى لا تبقى المخدرات وسيلة معيشية ومصدر الكسب.
رابعًا، ترسيخ مبدأ “المسؤولية المشتركة والمتوازنة” في التصدي العالمي للمخدرات. هذا يعني أن الدول المستهلكة الرئيسية للمخدرات عليها مسؤولية دعم الدول التي تكافح التهريب والإنتاج على أراضيها. وفي المقابل، الدول المنتِجة أو الممرّرة تحتاج للتعاون في كبح الإمداد. عبر هذه المسؤولية المشتركة يمكن تحقيق توازن يضمن تقاسم الأعباء بعدالة، فلا يُترك بلد بمفرده يواجه شبكات عاتية تمولها مليارات الدولارات. وفي السياق العربي، رفع مستوى التعاون مع الجوار الإقليمي كإيران وتركيا وأفريقيا ضروري أيضًا لنجاح أي جهود وطنية، نظرًا لأن طرق التهريب والمخاطر مرتبطة بهذه الجغرافيا الأوسع.
ضمان استدامة التنمية في العالم العربي يرتبط بشكل وثيق بقدرتنا على التصدي لآفة المخدرات والحد من تفشيها. صحة المجتمع وقدرته على الإنتاج هما عاملان رئيسيان في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التعاون العربي والدولي لمكافحة المخدرات هو في جوهره استثمار استراتيجي من أجل مستقبل وأمن واستقرار مجتمعاتنا والعالم بأكمله.
ملاحظة: تم نشر كامل محتوى المقابلة على موقع الاتحاد.
للإطلاع على ما نشرته صحيفة إرم نيوز: : الرابط الإلكتروني