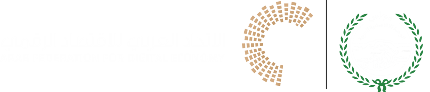أبوظبي
المصدر: جريدة الاتحاد
مفكرو الإمارات
أ.د. علي محمد الخوري
تحولت المعرفة في العالم المعاصر إلى البنية التحتية الخفية التي يُعاد بها تشكيل خرائط القوة العالمية، فالمعادلات السياسية والاقتصادية الجديدة تنطلق من فرضية أساسية تتمثل في أن من يملك القدرة على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، فسيملك في الوقت نفسه أدوات التفوق والنفوذ الاستراتيجي.
وهنا يلتقي مفهوم “القوة الناعمة” -الذي يشير إلى التأثير عبر الأفكار والمعايير- مع أطروحة “الرأسمالية المعرفية” التي تجعل من المكانة والشرعية والقدرة على التأثير رأس مال لا يقل أهمية عن رأس المال التكنولوجي أو المادي. ويضع هذا التحول العالم أمام سباق غير مسبوق نحو إنتاج المعرفة وتوظيفها، بعدّها دعامة تمكين مركزية في هندسة القوة والسيادة.
وتؤكد الأرقام أن سباق الدول نحو المعرفة يتسارع بوتيرة غير مسبوقة؛ إذ بلغ الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في عام 2023، ما يقارب 2.75 تريليون دولار، وفق المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وارتفعت حصة البحث والتطوير من الناتج المحلي العالمي في كثير من الاقتصادات المتقدمة لتتجاوز 2%، وسط توقعات بارتفاعها إلى 2.5% بحلول عام 2030 إذا ما استمرت السياسات الداعمة بوتيرتها في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. وتُبيّن هذه المؤشرات أن المعرفة، لا الموارد التقليدية، هي من سيحكم المستقبلَين الاقتصادي والسياسي، وأن القدرة على تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، هي معيار التفوق في موازين القوة العالمية.
وفي السياق العربي تكشف البيانات عن حراك مُتصاعد في بعض الاقتصادات، خاصة في الدول الخليجية، التي وضعت البحث والتطوير في قلب سياساتها التنموية؛ ففي دولة الإمارات ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في عام 2023 (أي نحو 1.75% من ناتجها المحلي الإجمالي)؛ لتصبح صاحبة الحضور الأقوى عربيًّا في المؤشرات الدولية المرتبطة بالابتكار والتنافسية.
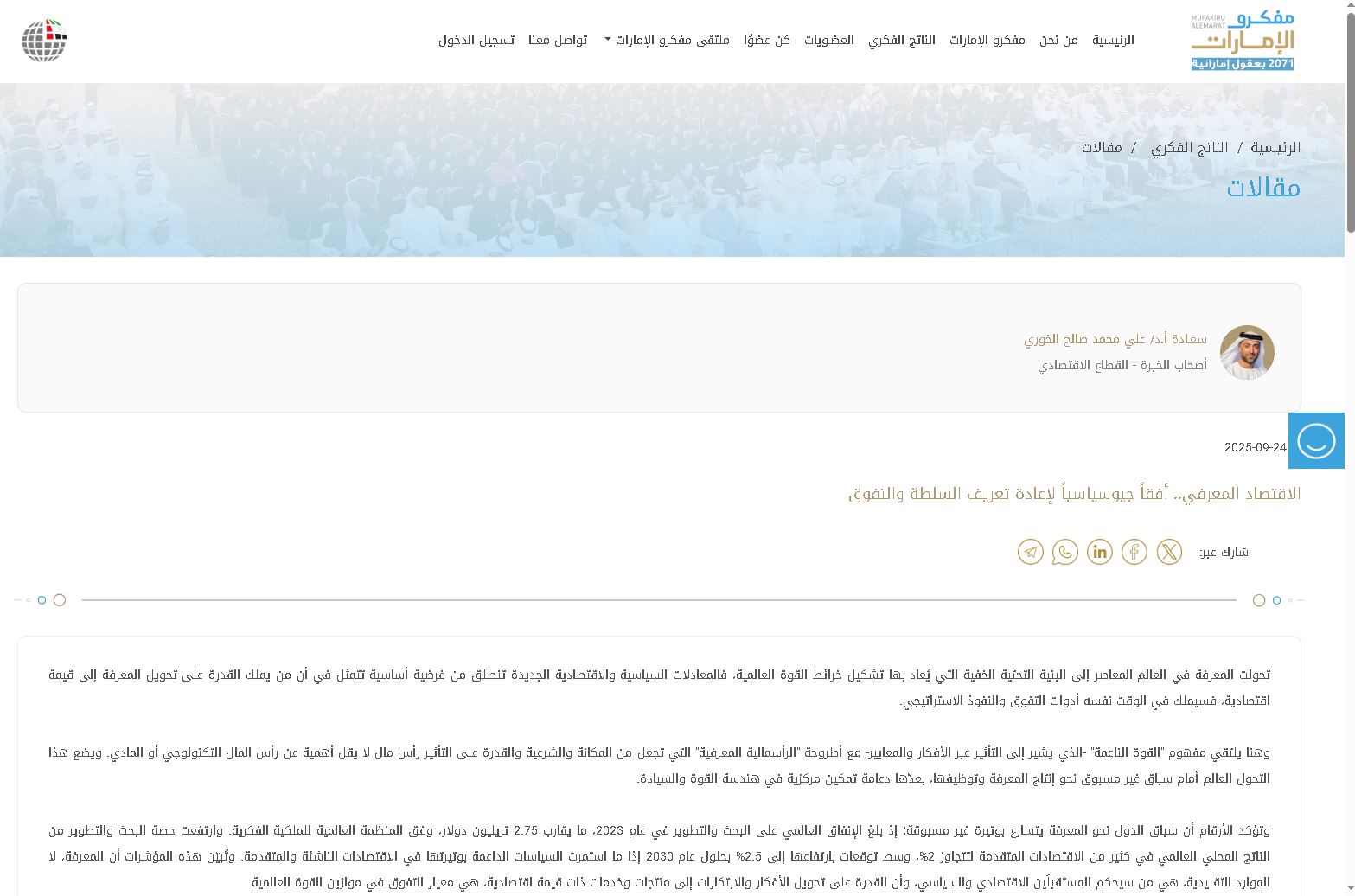
وفي المقابل تمثل المملكة العربية السعودية حالة لافتة للنظر من حيث معدل النمو في الإنفاق؛ إذ بلغت قيمة ما خصصته للبحث والتطوير نحو 6 مليارات دولار في العام نفسه بزيادة قدرها 17.4% عن عام 2022. كما سجلت قطر تقدمًا في موقعها العالمي؛ لتنضم مع الإمارات والسعودية إلى قائمة الدول الخمسين الأوائل في مؤشر الابتكار العالمي.
وتعكس هذه الاتجاهات سعي بعض الاقتصادات العربية إلى تنويع مصادر نموها عبر الانفتاح على مجالات التكنولوجيا والمعرفة، ومحاولة كسر الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية؛ ولكن التحدي الأكبر يظل في تحويل هذه الاستثمارات إلى منظومات إنتاج معرفي متكاملة، ليست قادرة على استهلاك التكنولوجيا المستوردة فقط، بل وإنتاج حلول وابتكارات أيضًا قابلة للتصدير والمنافسة عالميًّا.
وبرغم التقدم الملحوظ في بعض الاقتصادات العربية، تبقى الفجوة المعرفية واسعة عند مقارنتها بالمراكز العالمية المنتِجة للمعرفة. ويوضح المفكر إيمانويل والرشتاين، أحد أبرز منظّري العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في القرن العشرين، في نظريته عن “النظام العالمي” أن العالم ينقسم إلى مراكز تولّد الأفكار والتكنولوجيا، وأطراف تستهلكها. وبناءً على هذه النظرية، فإذا كان دخول بعض الدول العربية إلى قائمة الدول المبتكرة مؤشرًا إيجابيًّا؛ فإن القيمة الحقيقية تكمن في قدرتها على تقليص هذه الفجوة والتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج.
والواقع يكشف عن تحدٍّ أساسي يتمثل في نقص الكفاءات البحثية؛ فمتوسط عدد الباحثين في الدول العربية لا يتجاوز 650 باحثًا لكل مليون نسمة، مقابل أكثر من 4,000 في الاتحاد الأوروبي، وما يزيد على 7,000 في كوريا الجنوبية، وفق بيانات اليونسكو والبنك الدولي. وهذه الفجوة البشرية تجعل الاقتصادات العربية مُعرّضة لخطر ما يمكن تسميته “التبعية المعرفية”؛ إذ تبقى رهينة للتكنولوجيا المستوردة مهما توسعت في استثماراتها.
ومن هنا يصبح النظر إلى التجارب الدولية المتقدمة ضرورة لفهم كيف أمكن تحويل البحث العلمي من نشاط محدود الجدوى إلى أداة استراتيجية لبناء منظومات متكاملة. وفي دول شرق آسيا تبني الدول شبكات مُترابطة تجمع بين الجامعات والصناعة في حلقة ابتكار مُغلقة وسياسات مُمنهجة، لتحويل المعارف الأكاديمية إلى تطبيقات تجارية وصناعية داعمة للنمو المحلي والتوسع العالمي.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فتعمل بنموذج مغاير يقوم على ما يُعرف بـ “الدولة المُمكّنة”؛ فلا تتدخل الدولة لمزاحمة السوق، بل تعمل بصفة منظّم ذكي يضع الأطر والمعايير ويوجه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية وتنمية القطاعات الحيوية.

وتتحمل الشركات في الولايات المتحدة ما يقارب 80% من الإنفاق على البحث والتطوير، ولا سيما في مراحل التطوير التي تقترب من التطبيق التجاري، بينما تركز الحكومة الفيدرالية على تمويل البحوث الطويلة الأمد، وترسم السياسات والقوانين والاتجاهات العلمية التي يعتمد عليها القطاع الخاص لاحقًا، ومنها بحوث الطاقة المتجددة أو علوم الفضاء. أما حكومات الولايات فتؤدي دورًا تكميليًّا في تمويل البحوث على المستوى المحلي، بدعم الجامعات والمختبرات، وتوفير الحوافز الضريبية، وبناء بيئات بحثية وتكنولوجية تساعد الشركات الناشئة على تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تخدم احتياجات المجتمعات المحلية والمناطقية.
والدرس الذي تُسجله التجارب الدولية هو أن البحث العلمي يتحول إلى قوة استراتيجية حين يُدمج في مشروع وطني يعيد وصل المعرفة بالاقتصاد، ويُدار على أنه بنية تحتية للسيادة وتحقيق الغايات الوطنية العليا.
وإذا كان قطاع البحث والتطوير يمثل البنية التحتية الأولى لاقتصاد المعرفة، فإن الاقتصاد الرقمي يمثّل صورته التطبيقية الأبرز في النشاط الاقتصادي وأنماط التبادل المُعاصر؛ فبناء منظومات رقمية مُتقدمة يعني عمليًّا تحويل مخرجات البحث والابتكار إلى قيمة قابلة للتداول والتوسع.
وتبرز التجربة الخليجية باعتبارها نموذجًا ملموسًا؛ إذ وضعت دولة الإمارات هدفًا يكمن في رفع إسهام الاقتصاد الرقمي إلى ربع الناتج المحلي خلال عقد، فيما سجلت السعودية بالفعل نحو 15.6% عام 2023 من الأنشطة الرقمية. وعلى الرغم من تفاوت مستويات التقدم، فإن الصورة الأوسع في العالم العربي تكشف عن وعي متنامٍ بأهمية الرقمنة؛ إذ بدأت دول عدة تطوير بناها التحتية الرقمية، وتوسيع استثماراتها في قطاع التكنولوجيا، وإطلاق مبادرات وطنية تسعى لخلق بيئات ابتكار محلية قادرة على المنافسة.

ويُشير هذا التحول إلى انتقال تدريجي من الاعتماد على الريع المادي المتأتي من النفط والموارد الطبيعية، إلى ما يمكن تسميته “ريع الخوارزميات”؛ إذ تُستولد القيمة من البيانات ومنصات الذكاء الرقمي أكثر مما تُستخلص من الموارد التقليدية. غير أن النظريات النقدية في الاقتصاد السياسي تحذر من أن الاقتصادات هنا قد تقع في قيد “التبعية التكنولوجية”، وتظل رهينة لملكية فكرية خارجية تُقيد خياراتها السيادية؛ إذ تتحكم الشركات العالمية الكبرى في مفاتيح المعرفة ما لم تتمكن من إنتاج تقنياتها المحلية الخاصة.
ولن يتحقق بناء اقتصاد معرفي قادر على الصمود في مواجهة التحديات العالمية إلا برؤية وطنية شاملة تعيد تعريف أدوار الدولة والسوق والمؤسسات التعليمية وتنظيمها؛ فاقتصاد المعرفة لا يمكن أن يتحقق في بيئات مجزأة أو سياسات متفرقة، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجعله في صميم المشروع التنموي.
وعلى مستوى السياسات العامة تقع على عاتق الحكومات مسؤولية توجيه الاستثمارات نحو البحث العلمي والابتكار، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليتحول إلى شريك رئيسي في إنتاج المعرفة. وتبرز هنا أهمية دعم الحلول المحلية القابلة للتوسع الإقليمي والعالمي، وبما يحوّلها إلى قيمة اقتصادية قابلة للتداول.
والجامعات -بدورها- لا بد أن تتحول من كونها قاعات للتدريس إلى منصات إنتاج معرفي ترفد الصناعة بالابتكار وتغذي الاقتصاد بالأفكار القابلة للتطبيق. كما يتطلب الأمر تطوير أدوات تمويل جريئة تستهدف دعم الابتكار في المجالات التقنية المُعقدة بما يتيح نقل الأفكار من المختبرات إلى الأسواق. وإلى جانب ذلك يُصبح لزامًا تطوير بنية مؤسسية لإدارة البيانات وحوكمتها، بعدّها موردًا سياديًّا توازي في قيمتها الموارد الحيوية الأخرى، ولتكون مصدرًا لزيادة الإنتاجية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

وما ذُكر هنا ليس سوى موجّهات عامة تضع الإطار من دون أن ترسم المسار الكامل؛ فالمعطيات والتحولات الراهنة تضع صانعي القرار وراسمي السياسات أمام تساؤلات وخيارات ستحدد معايير الاستقلال الاقتصادي وأسس السيادة المعرفية وحدود التنافس الدولي. وسيظل مستقبل التنمية في العالم العربي مرتهنًا بمدى قدرة الحكومات على تحويل المعرفة إلى محرك فعلي للاقتصاد وأداة فاعلة لصنع القرار. ولن تكون زيادة المخصصات أو تشييد بنى تحتية رقمية متقدمة، برغم أهميتها، كافية ما لم تربط الأسباب بالنتائج، وتُفعّل المعرفة ضمن منظومة إنتاجية متكاملة. المعنى الفاصل هنا يكشف أن تحويل المعرفة إلى رصيد استراتيجي هو شأن مُرتبط بحماية الأمن الوطني والقومي، والوسيلة الوحيدة للعبور إلى الفضاءات غير المرئية التي باتت تختزن مفاتيح المستقبل.