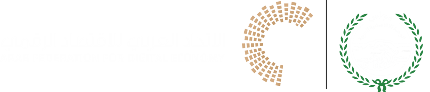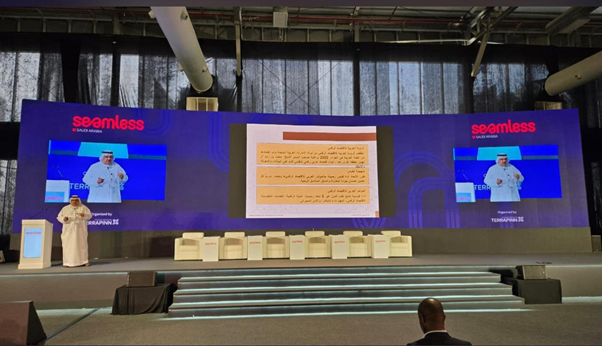أبوظبي
المصدر: مفكرو الإمارات
أ.د. علي محمد الخوري
في صيف عام 2025 شهدت أسواق النفط حالة من التذبذب الحاد، تأرجحت بين تهديدات أمريكية صريحة، وهدوء نسبي فرضته منصات التفاوض الدبلوماسي؛ وهذا التوتر كشف عن عمق الصراع الجيو-اقتصادي الجديد؛ إذ لم يعد النفط في عام 2025 “السلاح الكلاسيكي” بيد المنتجين؛ بل أصبح عملة سياسية صلبة تُستخدم في فرض الإرادات، ورسم خرائط النفوذ الدولي.
وجاءت الإشارة الأبرز في مطلع أغسطس؛ حين أصدر البيت الأبيض قرارًا تنفيذيًّا نص على فرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية من الهند قدرها 25 في المئة؛ وذلك رد فعل على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، الذي عَدته الإدارة الأمريكية دعمًا غير مباشر لآلة الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد دخلت هذه الرسوم حيِّز التنفيذ في 27 أغسطس 2025؛ لترفع الرسوم الإجمالية على كثير من البنود إلى ما يقارب 50 في المئة.
وفي الوقت نفسه كثفت واشنطن تهديداتها بعقوبات إضافية على الدول المستوردة للنفط الروسي؛ ما يطرح إمكانية فرض تعريفات جمركية ضخمة تصل إلى 500 في المئة على البلد المخالف؛ إذا لم يتوقف عن الشراء. وهذه الإجراءات، إلى جانب الرسوم الأمريكية، أدخلت أسواق النفط في حالة توتر مزدوج الأبعاد؛ اقتصاديًّا بفعل انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار، وديناميكيًّا بسبب دفع الأسواق نحو الصراعات الجيوسياسية والتوجُّهات العقابية.
القراءة بين السطور
حملت الرسالة الأمريكية في طياتها تحذيرًا سياسيًّا واضحًا، مفاده أن الحياد في الصراعات الكبرى لن يكون خيارًا بلا ثمن. وبرغم أن الدول المتأثرة عَدت القرارات الأمريكية “غير عادلة وغير مبررة”؛ فإن ذلك لن يغير شيئًا في أيديولوجيا الإدارة الأمريكية، التي تتعامل مع هذه المسألة كإملاءٍ أحادي لا يقبل النقاش؛ تاركةً العالم يتحمل تبعات قراراتها الثقيلة، ودافعةً بالأسواق نحو متاهات ضبابية.
وعلى الرغم من أن لقاء ألاسكا بين ترامب وبوتين، في 15 أغسطس، أهدى لمحة اعتدال مؤقتة، وأبان أن القاطرة السياسية لا تزال تحتفظ بمساحة للحوار وتبادل المواقف، بعيدًا عن منطق العزل الكامل؛ فإنه لم يطوِ ملف التوترات القائمة. ومن مبدأ العلاقات الدولية؛ فإن مثل هذه الاجتماعات قد تكون تكتيكات وقائية مقصودة لتبريد الأجواء الاقتصادية، والسماح ببقاء درجة من التوازن بين الاستقرار السياسي، وحاجات الاقتصادات المحلية والأسواق العالمية، ومنعها من الانزلاق نحو فوضى غير قابلة للسيطرة.
أدوات الضغط الأوروبي والسياسة السعرية
من قلب هذا الإطار السياسي المتأرجح أقبل الاتحاد الأوروبي، في 18 يوليو، على خطوات استباقية من نوع جديد؛ إذ خفض سقف السعر الروسي إلى 47.6 دولار للبرميل، على أن يطبق ابتداءً من 3 سبتمبر مع آلية مراجعة نصف سنوية تضمن أن تبقى الأسعار أقل بفارق نحو 15 في المئة من السوق؛ ما يعني بوضوح أن السوق الأوروبية تسعى إلى ترسيم سقف لأسعار الطاقة يحفظ مصالحها؛ بدل الانقياد لتقلبات الطلب والعرض. وإضافةً إلى ذلك أُعلِن أن استيراد المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي عبر دول أخرى سيُمنع ابتداءً من 21 يناير 2026.
كما امتد الاهتمام إلى السفن التي تنقل هذه المنتجات؛ بإدراج 105 ناقلات إضافية ضمن قوائم “أسطول الظل”، وحظر خدمات الموانئ والتأمين والخدمات البحرية عليها؛ لمنع محاولات الالتفاف؛ أو التحايل القانوني. وتترابط هذه الخطوات لإنتاج آلية رقابية تُستخدم لتوجيه السوق؛ والتحكم فيها؛ تقوم على المزاوجة بين النفوذ السياسي (مثل العقوبات، أو سقف السعر)، والأدوات التكنولوجية (مثل تتبع بيانات الناقلات بالأقمار الصناعية، وأنظمة مراقبة الشحنات)، كأعمدة مركزية لإدارة الإمدادات النفطية في الأسواق.
تأرجح أسعار خام برنت
عكست حركات الأسواق والأسعار حالة الارتباك التي فرضتها الإشارات السياسية المتناقضة؛ إذ لامس خام برنت مستوى 65 دولارًا للبرميل في 13 أغسطس، قبل أن يتعافى تدريجيًّا ليعود إلى ما يقارب 68-69 دولارًا بحلول 25 أغسطس. ولا يمكن قراءة هذا التأرجح السعري كمعادلة اقتصادية، أو تفسيره بعوامل السوق التقليدية وحدها؛ بل بانعكاس حي لتبدُّل إيقاع النبرة السياسية، وحسابات المناورات الدبلوماسية.
“العلاوة السياسية” في السعر
لا يمكن فهم تقلبات النفط من دون إدراك ما يسمى “علاوة المخاطر السياسية”، وهي الجزء الإضافي من سعر النفط الذي لا تحدده قوانين العرض والطلب التقليدية، بل تمليه ظروف السياسة الدولية والأمن الجيو-استراتيجي.
ففي حال انخفض سعر خام برنت إلى 65 دولارًا، كما تورده بعض التقارير، في حين أن التقديرات النظرية (وفق التوازن بين العرض والطلب والمخزونات) تشير إلى مستوى ما بين 59 و60 دولارًا؛ فإن هذا الفارق –أي العلاوة السياسية- (5-6 دولارات) هو ما سيعكس حالة القلق من العقوبات، والتوترات في الممرات البحرية، وقرارات أوبك بلس؛ بل حتى لهجة الخطاب السياسي بين واشنطن وموسكو.
وستحاول الأسواق، في مثل هذا المشهد، إيجاد توازن بين الواقعين الاقتصادي والسياسي؛ فإذا ما ظهرت إشارات تهدئة؛ فقد تتقلص العلاوة؛ وينخفض السعر نحو المستوى النظري. أما إذا ارتفعت حدة التوتر؛ أو ظهرت أخبار عن عقوبات جديدة؛ أو تهديد للممرات البحرية؛ فسترتفع العلاوة؛ وسيقفز السعر فوق قيمته الاقتصادية؛ ومن ثم يصبح النفط العربي خاضعًا لساعة سعرية مُركبة؛ السعر يُقرره المعروض والطلب والمخزون، والعلاوة تُحدِّدها القرارات السياسية والتأمين والتمويل واللوجستيات.
معطيات العرض والطلب: الاقتصاد وراء الكواليس
في ظل هذه التفاعلات لا تبدو معادلات الأسعار متجهة نحو تصاعد مُطلق؛ إذ إن بيانات التقارير العالمية “تُلوِّن” المشهد بواقعية. وبحسب وكالة الطاقة الدولية تقدر مستويات النمو في الطلب العالمي بـ680 ألف برميل يوميًّا في عام 2025، و700 ألف في عام 2026؛ ليصل الاستهلاك إلى 104.4 مليون برميل يوميًّا.
وفي المقابل تشهد المصافي العالمية مستويات تشغيل غير مسبوقة؛ ما أسهم في تحسُّن هوامش التكرير بشكل ملحوظ؛ وقد بلغت المخزونات النفطية العالمية نحو 7,836 مليون برميل في يونيو، في حين انخفضت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 2,758 مليون برميل؛ لتقترب من أدنى مستوياتها في العقد الأخير.
ويشير هذا التباين إلى أن الزيادة في المخزونات لم تعد تتركز في مراكز التسعير التقليدية، بل تتوزع في أسواق ناشئة وغير تقليدية، وتحديدًا في الصين، وعلى الناقلات البحرية خارج نطاق الدول الغربية. وبرغم أن هذا التراكم يستدعي المتابعة الدقيقة؛ فإنه لا يُعد مؤشرًا إلى حالة تشبُّع عالمي في الإمدادات؛ بل يعكس تحولًا في مواقع التخزين وتوزيع الفائض.
استقلال القرار النفطي العربي بين التحديات الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية
تستشرف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ضغطًا عرضيًّا قد يخفض متوسط سعر برنت إلى نحو 58 دولارًا في الربع الرابع من عام 2025، وربما إلى نحو 49 دولارًا في مطلع عام 2026، قبل أن يبدأ انتعاش بطيء يرتفع معه السعر تدريجيًّا. وهذه الموازنة بين ضغط العرض وتراكم المخزون من جهة، وضغط العقوبات واللوائح من جهة أخرى؛ تضع النفط العربي في موقع فريد يتطلب من الحكومات توظيفه بذكاء؛ لكيلا تسمح بأن تُفرض عليها سياسات تُضعف استقلاليتها؛ أو تصبح “أداة” في صراع القوى الكبرى.
وليست الدول العربية كلها في خانة واحدة؛ فبعضها (مثل السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، والجزائر، وليبيا) دول مصدِّرة رئيسية تعتمد موازناتها على عوائد النفط. وفي المقابل هناك دول أخرى (مثل مصر، والمغرب، والأردن، وتونس، ولبنان) هي مستوردة صافية تحتاج إلى تغطية جزء كبير من احتياجاتها من الخارج؛ وهذا التباين يجعل “النفط العربي” بصفته منظومة كلية في وضع مزدوج؛ بمعنى أن العالم العربي ينقسم إلى فريقين متعاكسين على جانبي المعادلة، أحدهما يربح من ارتفاع الأسعار، والآخر يتضرر منه.
المرونة الروسية المقرونة بتراجع الإيرادات
أثبتت روسيا مرونة لافتة للنظر في توزيع صادراتها؛ ولكنْ على وقع ارتفاع تكلفة الخصومات على المشترين، وعائدات النفط التي تهبط تدريجيًّا؛ ففي يونيو تراجعت الإيرادات النفطية من الخام والمنتجات إلى نحو 13.57 مليار دولار، بانخفاض نحو 14 في المئة سنويًّا. وقد تصل صادرات الخام والمنتجات إلى نحو 7.3 مليون برميل يوميًّا؛ وهو ما يمثل ضغوطًا مستمرة، ولكنها ليست قاتلة، على الاقتصاد الروسي.
أما نمو شراء الهند الخام الروسي؛ فقد سجل رقمًا قياسيًّا بنحو مليوني برميل يوميًّا في يونيو، في حين تظل الصين اللاعب الأكبر في استهلاك النفط الروسي. وهذا الوضع يوفر نافذة تكتيكية للمصدر العربي، ولكنه أيضًا يحمل مخاطرة سياسية في حال اشتد الحصار على التمويل واللوجستيات.
الفرص التكتيكية للمصدرين العرب
في هذا السياق المعقد يتكشف الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه الدول العربية؛ فالتشديد الأوروبي على المنتجات المكررة من الخام الروسي سيمنح دول الخليج والمغرب والجزائر وليبيا فرصًا تكتيكية لدخول أسواق جديدة، خصوصًا في أوروبا والبلدان التي تستورد الديزل ووقود الطائرات، ونافذة زمنية ثمينة يمكنها فيها توقيع عقود توريد طويلة الأجل بأسعار ثابتة، قبل انطلاق القيود الأوروبية على المنتجات المكررة في يناير 2026.
ويمكن لهذا التوقيت الفاصل أن يمنح المصدرين حصة سوقية إضافية؛ ولكن لتحقيق ذلك لا بد من تنسيق داخل أوبك بلس يسمح بزيادة مدروسة في التوريدات، وتقديم أسعار تنافسية تحترم حدود الفائض، وتوظِّف الترجمة السعرية لحماية الموازنات من المخاطر المحتملة لانزلاق السوق نحو فائض أسعار، وارتفاع التضخم المحلي.
إشكالات الاستيراد وتكلفة التحوُّل إلى السوق الروسية
بالنسبة إلى الدول العربية المستوردة؛ فقد يؤدي الاعتماد على مسارات تجارية غير مستقرة؛ والتدفُّقات الرخيصة المؤقتة، عبر طرق ليست تحت السيطرة المباشرة لتلك الدول، إلى مفاجآت مالية إذا أحكمت واشنطن، أو أوروبا، قبضتها بفرض رسوم، أو تغيير للمعايير.
إلى جانب ذلك؛ فإن تصاعد التوترات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن رفع أقساط التأمين من بضع عشرات من السنتات إلى ما يقترب من نقطة كاملة في بعض الحالات؛ ما يضاف إلى ثقل فاتورة الاستيراد على العملة والاحتياطي. وفي هذه الحالة، وإذا ما تقاطعت العلاوة السياسية من جهة، وتكاليف اللوجستيات والتأمين من جهة أخرى؛ فإن السعر الحكومي للوقود –الذي كان يُعد مدعومًا جزئيًّا– قد يُفاجَأ بخلوِّ الخزانة من أدواته التقليدية (مثل الدعم أو تثبيت الأسعار). ويمثل اعتماد التسعير المحلي المرن والقابل للتعديل الدوري؛ مقرونًا بشبكات الأمان الاجتماعي لفئات مستهدفة، أفضل الحلول المطروحة لتفادي أزمة اقتصادية مؤلمة.
جمع القراءات: السياسة، والسوق، والتشريع
ما يختلِف في هذا المناخ هو أن القراءات السطحية للأسواق لم تعد كافية؛ والمطلوب هو قراءة الصورة من خلال عدسة ثلاثية متراكبة: العدسة السياسية التي تقيس نبرة التهديد والدبلوماسية، والعدسة السوقية التي تقيس التوازن بين العرض والطلب والمخزون، والعدسة التشريعية التي تفسِّر كيف أن أقل تغيير في سقف السعر، أو المهلة القانونية، يمكن أن يُعيد موقف توازن السوق رأسًا على عقب.
والنفط العربي، اليوم، أمام نوافذ من فرص نادرة ومؤقتة؛ نافذة أوروبا التي ستحتاج إلى مزيد من المنتجات النفطية غير الروسية؛ ونافذة آسيا التي تشهد طلبًا متناميًا على الديزل، خصوصًا الهند وجنوب شرق آسيا؛ ونافذة التحوُّط السياسي داخل أوبك بلس للتنسيق السياسي والحفاظ على التوازن في الأسواق. وكل ذلك ينبغي استثماره بعقلانية ممتدة، واستراتيجيات طويلة المدى (بعقود توريد مستقرة، وتنويع الأسواق)؛ وليس باندفاع يُغرق الميزانيات في “فرص قصيرة” قد تؤدي إلى تقلبات مالية، أو تضخم داخلي.
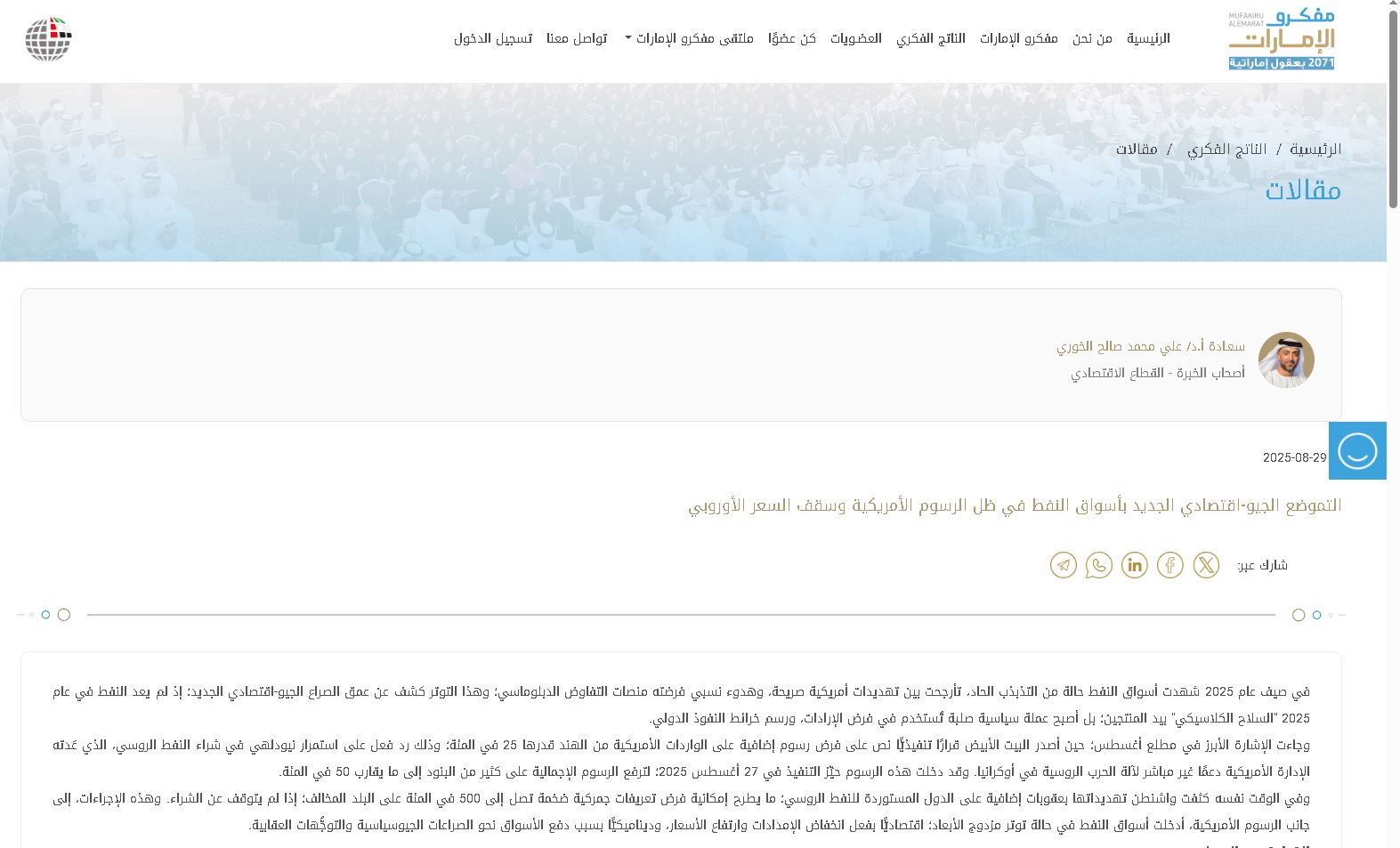
سيناريوهات محتملة للأشهر المقبلة
السيناريو الأول هو تصعيد محدود متقطع يرفع التكاليف قليلًا في السوق، في حين تظل الإمدادات مستقرة؛ والهامش محتفظًا بوزنه السياسي في التسعير. وفي هذا السيناريو قد تحدث تصعيدات محدودة؛ وتصل “علاوة المخاطر السياسية” إلى الحد الأعلى، ويدفع السعر مؤقتًا نحو نطاق 65–70 دولارًا؛ لكن مع استمرار تراجع الطلب؛ وارتفاع المخزونات؛ سيتجه سعر برنت إلى أقل من 60 دولارًا في الربع الرابع من عام 2025، ثم نحو 50 دولارًا في عام 2026، كما تتوقع منظمة الطاقة الدولية. وستتعامل السوق مع هذه الزيادة بصفتها مجرد فقاعة مؤقتة؛ إذ تبقى أسعار العقود مرتفعة برغم التوقعات الضعيفة.
والسيناريو الثاني يتعلق بحال فرض رسوم أو عقوبات إضافية على الهند والصين؛ وهو ما قد تنقطع معه مئات الآلاف من براميل النفط الروسي في الأسواق، ويدفع السعر مؤقتًا نحو 70-75 دولارًا؛ ولكن تطبيق هذه الإجراءات سيأتي في سياق فائض عالمي متزايد، بحسب وكالة الطاقة الدولية والمحللين؛ لذا من المرجح أن تكون القفزة قصيرة الأجل؛ تليها تسوية إلى مستويات أقل مع استجابة الإمدادات الإضافية، أي أن العلاوة السياسية لن تستمر طويلًا.
والسيناريو الثالث هو تهدئة نسبية تسمح بتراجع “العلاوة” تدريجيًّا؛ ولكن تظل حركة الطلب والاستعداد البحري والفائض المنتج تضغط سلبًا؛ فيهبط السعر إلى ما دون 55 دولارًا في مطلع عام 2026، وربما إلى أدنى من 50 دولارًا إذا ما بدأت المخزونات تتكدس بالوتيرة المتوقعة؛ في حال فشل الدول المصدرة في حماية حصتها، أو إدارة التدفق بطريقة ديناميكية ومرنة.
خريطة طريق المستقبل العربي
لا يكفي أن يقتصر الجزء الجوهري في بنية السياسات العربية الراهنة على حماية الثروات والقدرات النفطية القائمة؛ بل ينبغي أن يُبنى على تصورٍ استراتيجي بعيد المدى؛ يضع خططًا تجعل قطاع الطاقة العربي قادرًا على مواجهة تحولات السوق في العقدين المقبلين. ويجب أن يقوم هذا التصور على بُعد النظر في استيعاب أدوات العولمة الجديدة، مثل الرسوم الوقائية، والقيود السعرية المسبقة، وأقساط المخاطر السياسية.
والفكرة المحورية في التصور الاستراتيجي تكمن في تحويل تقلبات السوق إلى قوة إنتاجية مستدامة، لا في الارتكان إلى موجات من قرارات متسرعة أو غير مدروسة تُهدر الإمكانيات، وتُبدِّد الموارد؛ ولذلك فإن صناعات النفط العربية اليوم لا تحتاج إلى دخول منافسة في السعر وحده؛ بل إلى إدارة متوازنة، وفهم “علاقة السعر بالمخاطر”، وهي معادلة عصية على من لم يكن واقفًا على فهم القواعد السياسية وآليات التحوط المالي معًا.
واللحظة الفاصلة لا تحتمل ردود الفعل المرتجلة؛ فالاستراتيجيات هنا لا يمكن أن تُبنى على الانفعالات، بل على تكتيك مُمنهج ومتماسك ينطلق من تثبيت جسور الدبلوماسية، وتحصين الروابط مع القوى المؤثرة، ويُبقي لأوبك بلس مجالًا من المرونة في الحصص الإنتاجية، ويتعامل مع توقيع العقود بصفته أداة إدارة للمخاطر، وجزءًا من السياسة الاقتصادية، ويُحكم أدوات التحوُّط في وجه الرياح المتعرجة للأسعار.
كما أن إنشاء شبكة احتياطية للتمويل والتوريد يعد ضرورة، كتنويع الموردين، وتعدد العقود (فورية، متوسطة، طويلة الأجل)، وتنوع عملات الدفع، وخطوط الائتمان والتأمين وطرق الشحن البديلة، وينبغي ألا يصبح الاعتماد على السوق الروسية اعتمادًا بنيويًّا، بل خيارًا ضمن سلة أوسع.
ولا بد من حماية المستهلك من صدمات السوق عبر آليات التسعير الديناميكية، وتفعيل برامج الدعم المُوجهة؛ فهي المخرج الأنسب؛ شريطة ألا تتحول العلاقات السياسية الآنية إلى العامل المحدِّد لأسعار الوقود.