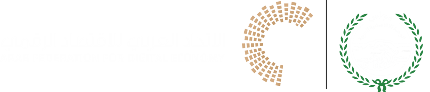القاهرة
المصدر: جريدة الوفد
أ.د. علي محمد الخوري
مثل هذا التحول لا يخلو من تحديات بنيوية. فتكاليف تقنيات الطاقة المتجددة لا تزال مرتفعة مقارنة بالوقود الأحفوري في العديد من الدول العربية، مما يشكّل عقبة تمويلية لدى الاقتصادات التي تعاني من اختلالات مالية وهيكلية. كما أن البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذه التقنيات ما تزال قاصرة، بدءًا من أنظمة النقل والتوزيع، مرورًا بتقنيات التخزين، ووصولاً إلى غياب منظومات بيانات دقيقة تُتيح التنبؤ بالاستهلاك وتوزيع الإنتاج بكفاءة. أضف إلى ذلك التحديات السياسية المرتبطة بضعف التكامل الإقليمي، وانعدام الثقة المؤسسية بين عدد من العواصم العربية، ما يُصعّب عملية بناء إطار جماعي للتحول في مصادر الطاقة.
المفارقة الكبرى تكمن في أن المنطقة العربية، رغم امتلاكها لمصادر الطاقة المتجددة بكثافة تُعدّ من الأعلى عالميًا، لا تزال تسجل نسب استخدام للطاقة النظيفة أقل من المتوسط العالمي. في المقابل، تتجه دول مثل المغرب ومصر والأردن نحو مشاريع طموحة للطاقة الشمسية والرياح، بما يمكن أن يُشكّل نواة لتحالفات إقليمية جديدة، بشرط أن يُعاد تعريف مفهوم التعاون العربي من كونه تنسيقًا ظرفيًا إلى كونه مشروعًا استراتيجيًا يمتد لعقود.
في مواجهة هذه المعطيات، من الضروري أن تُعاد صياغة الرؤية العربية للطاقة وفق منطق يتجاوز فكرة “الاستجابة للضغوط المناخية الدولية”، ليتم النظر إلى التحول في مصادر الطاقة بوصفه بوابة لبناء استقلال اقتصادي طويل المدى. هذه الرؤية تتطلب إصلاح المنظومات القانونية لتسهيل انتقال التكنولوجيا، وتحديث أنظمة التعليم والتدريب لبناء رأس مال بشري قادر على قيادة الابتكار الأخضر، وتأسيس بورصات طاقة شفافة تُحدد الأسعار بمعايير السوق لا بمعادلات الدعم السياسي.
إذاً، فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بمستقبل الطاقة، بل بمستقبل الدولة العربية في النظام الدولي. فكيف يمكن لعالم عربي أن يتفاوض على موقعه في خريطة الاقتصاد العالمي وهو يعتمد على نموذج تصديري أحفوري يتآكل في قيمته الاستراتيجية؟ وكيف يمكن تأمين مستقبل الأجيال القادمة إذا بقيت الاقتصادات العربية رهينة تقلبات أسعار النفط وأسواق الكربون الأوروبية؟
في هذه اللحظة التي تعاد فيها كتابة قواعد النظام الاقتصادي الدولي، قد يكون التعاون العربي في مجال الطاقة المتجددة هو الفرصة الأخيرة لبناء مشروع تكاملي عربي حديث، لا يقوم على الأطروحات الانفعالية أو الإنشائية، بل على حسابات دقيقة للمصالح، وتداخل واضح في الإنتاج والأسواق والتقنيات والسيادة.
قد يكون السؤال الأهم الآن هو عما إذا كانت الدول العربية ستنجح في الانفصال عن منطق «كل دولة بمفردها»، وتؤسس منظومة جماعية للطاقة النظيفة قادرة على صياغة دور عربي جديد في القرن الحادي والعشرين؟ أم أن فوات هذه اللحظة سيترك المنطقة في موقع المتفرّج على مشهد دولي يُعاد هندسته دونها؟ إن الإجابة على هذا السؤال لن تُكتب في المؤتمرات، بل في المشاريع، وفي خطوط الربط، وفي النماذج التي تختار الدول أن تطبقها اليوم، لا غدًا.