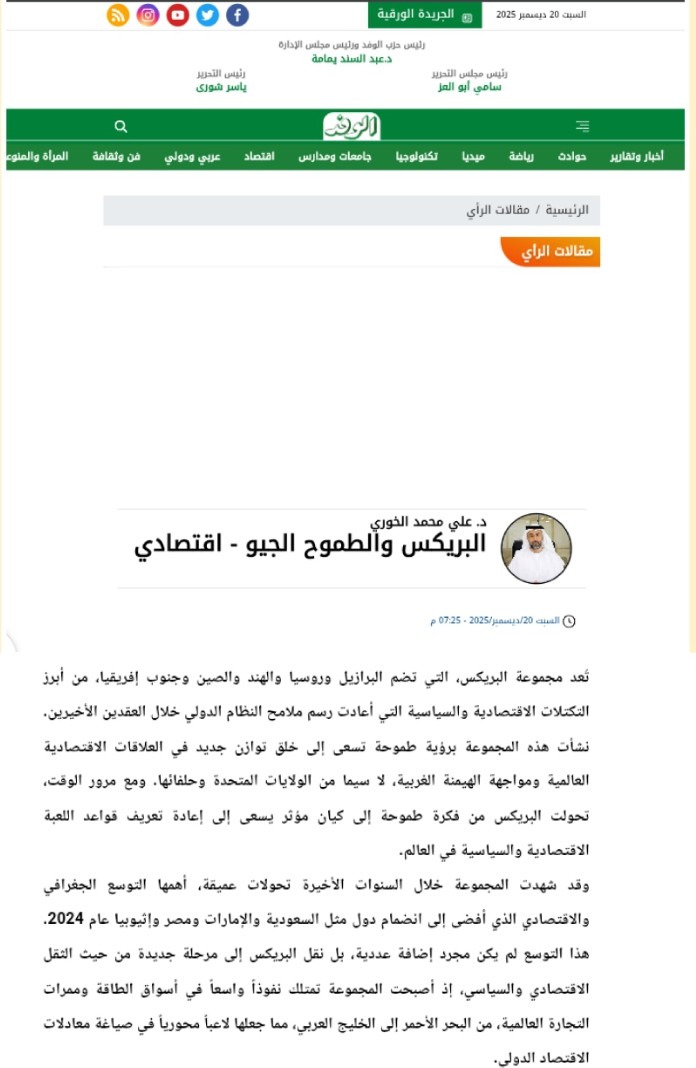المصدر: جريدة الوفد
أ.د. علي محمد الخوري
تُعد مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، من أبرز التكتلات الاقتصادية والسياسية التي أعادت رسم ملامح النظام الدولي خلال العقدين الأخيرين. نشأت هذه المجموعة برؤية طموحة تسعى إلى خلق توازن جديد في العلاقات الاقتصادية العالمية ومواجهة الهيمنة الغربية، لا سيما من الولايات المتحدة وحلفائها. ومع مرور الوقت، تحولت البريكس من فكرة طموحة إلى كيان مؤثر يسعى إلى إعادة تعريف قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية في العالم.
وقد شهدت المجموعة خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة، أهمها التوسع الجغرافي والاقتصادي الذي أفضى إلى انضمام دول مثل السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا عام 2024. هذا التوسع لم يكن مجرد إضافة عددية، بل نقل البريكس إلى مرحلة جديدة من حيث الثقل الاقتصادي والسياسي، إذ أصبحت المجموعة تمتلك نفوذاً واسعاً في أسواق الطاقة وممرات التجارة العالمية، من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، مما جعلها لاعباً محورياً في صياغة معادلات الاقتصاد الدولي.
من الناحية الاقتصادية، تمثل البريكس اليوم أكثر من 40% من سكان العالم ونحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعلها قوة يصعب تجاهلها في أي معادلة اقتصادية أو سياسية. وقد أطلقت المجموعة مبادرات نوعية مثل “البنك الجديد للتنمية” لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول النامية، في محاولة لإيجاد بدائل حقيقية للمؤسسات المالية الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما تسعى دول البريكس إلى تقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها البينية عبر استخدام العملات المحلية، وهو اتجاه تزداد أهميته في ظل العقوبات الغربية على روسيا والاضطرابات التي تشهدها منظومة المدفوعات العالمية. وقد طرحت بعض الأصوات فكرة إطلاق عملة موحدة لدول المجموعة، وإن كان ذلك لا يزال في إطار النقاشات النظرية، إذ يتطلب تنفيذها بنية مالية ومؤسسات نقدية متكاملة.
على الصعيد السياسي، أصبحت البريكس منصة حوار مؤثرة في مواجهة السياسات الأحادية التي ينتهجها الغرب، خصوصاً في قضايا مثل الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية والنظام التجاري العالمي. وتتبنى المجموعة سياسة تقوم على ما يُعرف بـ “التعاون بين دول الجنوب” – وهو المفهوم الذي يرمز إلى الشراكات بين الاقتصادات الصاعدة والدول النامية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية – بوصفه نموذجاً جديداً للعلاقات الدولية يرتكز على المصالح المتبادلة والتوازن في القوة الاقتصادية والسياسية بعيداً عن الهيمنة التقليدية للدول الصناعية الكبرى.
لكن مسيرة البريكس ليست خالية من الأشواك. فالتكتل يواجه تباينات حادة في الرؤى والمصالح بين أعضائه، لا سيما بين الصين والهند اللتين تتنافسان على النفوذ في آسيا والمحيط الهندي. هذه المنافسة تعيق التوافق على مواقف موحدة في قضايا استراتيجية. كما أن المواقف المتباينة من الحرب في أوكرانيا كشفت حدود التماسك داخل المجموعة، حيث تحاول البرازيل والهند الحفاظ على توازن دقيق بين مصالحها مع الغرب وعلاقاتها مع موسكو وبكين. في المقابل، يثير النفوذ الصيني المتزايد داخل البريكس مخاوف بعض الأعضاء من تحوله إلى أداة تخدم المصالح الصينية أكثر من كونه إطاراً تعاونياً متكافئاً.
إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة التنموية بين الأعضاء، وغياب سياسات نقدية ومالية منسقة، تجعل فكرة التكامل الاقتصادي الكامل صعبة التحقيق في المدى المنظور. كما أن استمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي يضع أمام البريكس تحديات هائلة في مساعيها لبناء نظام مالي مواز، خاصة في ظل استمرار قوة المؤسسات الغربية الراسخة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
أما من حيث المستقبل، فالمشهد ينفتح على سيناريوهين متناقضين. السيناريو الإيجابي يتمثل في قدرة البريكس على ترسيخ مكانتها كتكتل عالمي مؤثر، خاصة مع انضمام القوى النفطية الكبرى مثل السعودية والإمارات، ما سيمنحها ثقلاً غير مسبوق في سوق الطاقة ويدعم موقع اليوان الصيني كعملة تبادل دولية، الأمر الذي قد يسرّع الانتقال من عالم القطب الأوحد إلى عالم متعدد الأقطاب. أما السيناريو الآخر، فيتمثل في بقاء الخلافات الداخلية وتفاقم الضغوط الغربية، مما قد يحول البريكس إلى كيان رمزي بلا تأثير حقيقي، مع استمرار الدولار في قيادة النظام المالي العالمي وعودة الهيمنة الأميركية في السياسة والاقتصاد.
وفي أفق أكثر تأملاً، يمكن القول إن مستقبل البريكس سيعتمد على قدرتها على تجاوز خلافاتها الداخلية وصياغة رؤية مشتركة للعولمة الجديدة. فالعالم يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي، فمفهوم القوة اليوم يتجاوز الحدود الاقتصادية والعسكرية ليتمحور حول امتلاك الدول القدرة على نسج تحالفات استراتيجية مستقرة تقوم على الثقة والمصالح المتقاطعة. إذا ما نجحت البريكس في تحقيق هذا التحول، فقد لا تكون مجرد تكتل اقتصادي، بل بداية حقبة جديدة من إعادة تشكيل النظام العالمي على أسس أكثر توازناً وإنصافاً. أما إذا فشلت، فسيبقى العالم يدور في فلك القوى التقليدية ذاتها، ينتظر من جديد من يجرؤ على إعادة تعريف المستقبل.