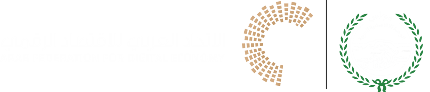القاهرة
المصدر: جريدة الوفد
أ.د. علي محمد الخوري
منذ قرون، شكلت الجغرافيا أحد أبرز محددات النفوذ في العلاقات الدولية، لكنها في الزمن الحديث اتخذت شكلًا أكثر تعقيدًا حين اقترنت باللوجستيات، والطاقة، والتدفقات التجارية. وإذا كان التاريخ قد منح العالم العربي موقعًا وسطًا بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، فإن سؤال الاستفادة من هذا الامتياز الطبيعي ظل مُعلقًا، يتأرجح بين فرص كامنة غير مُفَعّلة، وتحديات بنيوية تزداد تعقيدًا في سياق الاقتصاد العالمي المتحوّل.
اليوم، ومع احتدام التنافس بين الممرات البحرية الدولية، يتقدم المشهد العربي كفاعل مُحتمل في معادلة السيطرة على شرايين التجارة العالمية، لا سيّما في ظل إشراف عدد من الدول العربية على مفاصل بحرية استراتيجية، مثل قناة السويس، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب. هذه الممرات ليست مجرد معابر مائية، بل هي نقاط ارتكاز لمستقبل الاقتصاد السياسي في المنطقة.
قناة السويس، على سبيل المثال، تحولت من مشروع حفر فرضته مصالح التوسع الأوروبي في القرن التاسع عشر إلى مصدر دخل سيادي. في عام 2023، وصلت إيرادات القناة السنوية إلى ما يقارب 9.4 مليار دولار، بحسب بيانات هيئة قناة السويس، ليجعلها من أكثر القنوات الملاحية ربحية في العالم. لكن الحكاية لا تقف عند هذا الحد. إذ إن ما ينطبق على مصر يمكن – من حيث الإمكان – أن يمتد إلى الدول المُطلة على مضيق هرمز أو باب المندب، إذا ما أُعيدت هندسة التفكير في هذه الممرات كمنصات اقتصادية شاملة، لا كمجرد نقاط عبور.
إذ تتيح هذه الممرات للدول العربية أن تتحول إلى حلقات حيوية في سلاسل التوريد العالمية، بما يتجاوز مجرد العبور نحو احتضان الأنشطة اللوجستية والتخزينية، وإنشاء مناطق صناعية تركز على الصناعات المرتبطة بالتجارة العابرة، بل وحتى إعادة التصدير والتجميع. وفي ظل مساعي العديد من الاقتصادات العربية لفك الارتباط النسبي عن الريع النفطي، يبدو الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالملاحة والنقل البحري، خيارًا استراتيجيًا يأخذ بعين الاعتبار قابلية الاستدامة، ومواءمة التحولات الهيكلية في نمط التجارة العالمية.
تملك الدول العربية أدوات مالية ضخمة عبر صناديقها السيادية، التي تدير تريليونات الدولارات، من الرياض إلى أبوظبي إلى الدوحة والكويت. ويمكن لهذه الموارد أن تُستخدم لا في تمويل العجز، بل في تأسيس شبكات متكاملة من الموانئ الذكية، وأنظمة الملاحة، والمراكز اللوجستية، وشركات الشحن الإقليمي، ومؤسسات بناء السفن وصيانتها، بما يحول هذه الممرات من ممرات عبور إلى مراكز قرار.
الفرصة الحقيقية تكمن في تحوّل المنطقة من منطقة مرور إلى نقطة مركز. ذلك لا يتطلب فقط استثمارات مالية، بل أيضًا رؤية وإرادة سياسية تؤمن بمفهوم التكامل الإقليمي، وتستطيع التوافق حول مشاريع استراتيجية عابرة للحدود، خصوصًا في ظل التنافس الدولي المحتدم على إعادة تشكيل جغرافيا الممرات البحرية، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي.
لكن المسار ليس بلا تحديات. فحالة التفرّق السياسي العربي، إلى جانب الأزمات الأمنية الممتدة في عدد من الدول المطلة على الممرات الاستراتيجية، تخلق بيئة طاردة للاستثمار، وتُضعف من مصداقية المنطقة كلاعب موثوق على خريطة التجارة البحرية العالمية. يُضاف إلى ذلك استمرار البيروقراطيات المُعطّلة، وضعف الإطار التشريعي المتعلق بالاستثمار الأجنبي، وتضارب المصالح بين الدول العربية ذاتها، التي لم تصل بعد إلى صيغة تكاملية تؤسس لعلاقات اقتصادية استراتيجية مستدامة.
كما أن التحدي لا يقتصر على الداخل فقط. فالدول العربية تواجه منافسة متصاعدة من موانئ إقليمية مثل ميناء بيريوس في اليونان، الذي تستثمر فيه الصين ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، وميناء جبل علي في دبي، الذي يتبنى نموذجًا متقدمًا في التكامل بين الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية.
ومن أجل تجاوز هذه العقبات، لا بد من تبني سياسات استثمارية قائمة على الوضوح، والشفافية، وتقليل المخاطر النظامية، وبناء شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص. كما يتطلب تطوير البنية التحتية رؤية تتجاوز الحلول السريعة نحو تخطيط طويل الأجل يأخذ في اعتباره البعد البيئي، والرقمي، والتحولات الجيوسياسية الكبرى.
في هذا السياق، تبدو الحاجة مُلحّة إلى مشروع عربي مشترك يتبنى إعادة هندسة المشهد الملاحي العربي برؤية موحدة، تدفع باتجاه بناء منصة لوجستية إقليمية، يمكن من خلالها توحيد المعايير، وتبادل البيانات، وتدريب الكفاءات، واستقطاب التقنيات الذكية، بما يخلق كتلة بحرية عربية فاعلة، قادرة على التفاوض مع القوى الكبرى من موقع الشراكة المتكافئة، لا من موقع التبعية أو العبور الصامت.
ولعل اللحظة الاستراتيجية الراهنة، بما تحمله من تصاعد في التوترات الجيو-اقتصادية العالمية، تُشكل فرصة لإعادة تموضع العرب في قلب التجارة البحرية العالمية. فحين تتفكك بعض المسارات التقليدية للتجارة بسبب النزاعات أو الكلفة أو التعقيد، فإن المسارات البديلة لا تُخلق فقط بالخرائط، بل تُخلق بالاستثمار في الجاهزية، والقدرة، والموقع.
وفي تأمل أكثر عمقًا، تبدو الممرات المائية، في السياق العربي، اختبارًا لإرادة البناء، ومقياسًا لمدى قدرة الجغرافيا أن تتحول إلى مشروع استراتيجي قابل للتنفيذ. غير أن الاعتماد على الموقع وحده لا يكفي لبناء مكانة اقتصادية مستدامة. فالجغرافيا، مهما بدت واعدة، لا تكتسب قيمتها إلا إذا أُدرجت ضمن إطار مؤسسي متماسك، يقوم على كفاءة تشغيلية، وهياكل تمويل مستقرة، ورؤية استثمارية قادرة على التفاعل مع المتغيرات الدولية. التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الممر، بل في امتلاك القدرة على توظيفه ضمن شبكة المصالح العالمية بصيغة تضمن قيمة مضافة. أما من يتباطأ في بناء هذا النوع من الجاهزية المؤسسية، فلن يكون شريكًا في رسم حركة التجارة الدولية، بل تابعًا لمعادلات تُحدَّد خارجه.