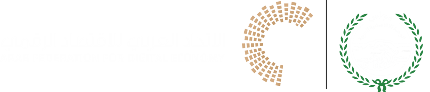أبوظبي
المصدر: مفكرو الإمارات
أ.د. علي محمد الخوري
لم يعد مفهوم “التفاهة” مُجرد إشارة إلى رداءة المحتوى، أو سطحية التفكير، بل تحول بنيةً ثقافية وإعلامية مُعقدة، تقود عملية لإعادة تشكيل الوعي الجمعي للأفراد والمجتمعات، وتُعيد ترتيب أولويات التأثير في فضاءات النقاشات العامة.
والتحول الأكثر إثارةً للتساؤل هو أن العالم، في نسخته الرقمية الجديدة، لا يُقيم الأشخاص بناءً على ما يحملونه من علم، أو فكر، أو قيمة اجتماعية؛ بل بناءً على ما يجمعونه من تفاعلات ومتابعين وإعجابات؛ فيُعطى الاعتبار للمظهر وللشكل الخارجي لا للمحتوى، وتُوزن الأفكار بمدى انتشارها لا بمضمونها.
وشهدنا، خلال العقد الأخير، تسارعًا غير مسبوق في تعميم ما يُمكن وصفه بـ”ثقافة الاستسهال”؛ وهذه الثقافة لا تكتفي بإقصاء العمق، بل تحتقره علنًا، وتُعيد تشكيل الذائقة العامة وفق نماذج مختزلة، مبنية على مفردات الإثارة، والغرابة، والسطحية المُطلقة. ويكفي أن نُلقي نظرة على أكثر محتويات المنصات الرقمية انتشارًا لندرك حجم التراجع المهول في معايير التفكير والسلوك والذوق العام.
وفي السياق العربي اكتسبت هذه الظاهرة بُعدًا أكثر تعقيدًا؛ إذ تتلاقى البنية الثقافية، التي لا تزال تبحث عن توازنها، مع ضعفِ البنيتين التشريعية والتنظيمية؛ ليُنتجا بيئة مثالية لتفشي التفاهة؛ وتُحولاها قوة تأثير.
وبحسب دراسة نشرتها منصة MeaTechWatch في إبريل 2025 يقدَّر عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بنحو 228 مليون شخص، في مؤشر واضح إلى التغلغل الرقمي المتسارع في الحياة اليومية؛ ويقدر تقرير DataReportal أن دول الخليج تُعد الأكثر كثافةً في الاستخدام؛ إذ تصل النسبة إلى 94% في السعودية، و112% في الإمارات، مقابل نحو 44% في مصر.
وهذه الأرقام تكشف عن مساحات هائلة من الوقت تستهلكها تطبيقات، الأغلبية الساحقة منها لا تُنتج معرفة حقيقية؛ ولا تُحفز التفكير، بل تُكرس تصورات زائفة ومشوهة عن الإنجاز، والقيمة الشخصية، ودور الفرد في الحياة.
وما يُعمق المشكلة هو أن محتوى المنصات لا يقف هنا عند حدود الإضحاك، أو استعراض اللحظات اليومية التافهة، بل يتعدى ذلك إلى تأثير عميق في تكوين العقل الجمعي. وتُنتِج التفاهة نوعًا من التفكير الكسول، وتُشجع على الاستهلاك السلبي للمعرفة، وتُغلق الأفق النقدي للفرد؛ وفي مثل هذا المناخ تنجح الخوارزميات -التي لم تعد مجرد أدوات برمجية، بل أنظمة توجيه سلوكي– في تدعيم هذا الانحدار؛ فالمحتوى الذي يُفضله الجمهور يُعاد ضخه بكثافة، فيما يُهمش المحتوى الفكري، حتى لو كان ذا قيمة عالية؛ وهكذا يُصبح “الطلب الجماهيري” هو المعيار الوحيد للبقاء الرقمي؛ بصرف النظر عن الجودة، أو الحقيقة.
وقد تَنبه الفلاسفة والمفكرون الكبار إلى هذه الإشكالية منذ قرون؛ فقال سقراط: “تحدث حتى أراك”؛ وكذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين قال: “كنت أهاب الرجل حتى يتكلم”؛ فالكلام، والفكرة، والبيان، كانت، وما زالت، أدوات تقييم الإنسان.
أما اليوم؛ فقد أصبح السكوت المقنع في فيديو مُمنتج جيدًا أكثر تأثيرًا من نص عميق؛ وبدلًا من “صناع المعرفة” يُحتفى الآن بـ”صناع التفاهة”، الذين لا يُقدمون محتوى يُغني العقل، بل يُنتجون ترفيهًا استهلاكيًا بلا قاع، هدفه الوحيد استدرار التفاعل، وتضخيمه، لا بناء العقل.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على إلباس السطحية ثوبًا جميلًا، بل تتجاوز ذلك إلى تأسيسٍ لحالة من الاغتراب النفسي والفكري؛ فالشاب الذي يُتابع المؤثرين على “تيك توك” أو “سناب شات”، أو “إنستجرام” حيث تُباع الأوهام على هيئة واقع يومي، يجد نفسه أمام توقعات مرتفعة عن الحياة لا يملك أدوات تحقيقها؛ وهنا تبدأ الحلقة الأخطر، وهي القلق، والتوتر، والاكتئاب، وانعدام الثقة بالنفس.

وتؤكد هذه الحقيقةَ الدراساتُ الحديثة كالصادرة عن جامعة “نيو ساوث ويلز” في أستراليا عام 2023، بأن الاستخدام اليومي المكثف لوسائل التواصل يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب بنسبة 30%، ولا سيما في الفئة العمرية ما بين 14 و24 عامًا.
والواقع الذي نعيشه جميعًا يكشف أن هذه النسبة قد تكون أعلى من تلك المُقدرة؛ وأن الآثار النفسية لوسائل التواصل غير مقتصرة على الشباب؛ بل تمتد لتشمل مختلف الفئات العمرية بلا استثناء.
والتفاهة إذن هي آلة لإنتاج فكر مشوه لا يُميز بين الرأي والمعلومة، وبين الحقيقة والشائعة. هي حالة تُربك أدوات الفهم، وتُشوش على الإدراك، وتُبدل الأولويات؛ وتحت هذه الهيمنة باتت الأفكار الغربية العدمية –التي تروّج لفكرةِ أنه لا جدوى لأي شيء– أكثر جاذبية وانتشارًا، مستفيدة من فراغ فكري عربي، تُرك عن غير قصد أو تهاون لمؤثرين لا يملكون من الفكر إلا الانفعال، ولا من الرسالة إلا الضجيج.
وما يدعو إلى القلق أكثر هو أن التفاهة أصبحت مدعومة ببُنى مؤسساتية، بعضها إعلامي، وبعضها اقتصادي؛ فهناك صناديق استثمارية تدعم المحتوى الفارغ؛ لأنه يجلب الأرباح السريعة؛ وهناك منصات تروج له؛ لأنه يُبقي المستخدم مشدودًا أمام الشاشة، ويزيد من فرص التفاعل وتحقيق الأرباح الإعلانية. وهناك جمهور اعتاد هذا النوع من المحتوى حتى أصبح يرى فيه المثال الطبيعي لما يجب أن يكون؛ بغض الطرف عن قيمته، أو مضمونه؛ وفي ظل هذا المشهد لم يعُد تحقيق الانتشار الرقمي مرتبطًا بالقيمة، أو المعرفة، بل بمن يجرؤ على كسر المعايير ولو بالسخف.
أما على المستوى الاستراتيجي؛ فإن استمرار هذا النهج يُهدد بانهيار البنية المعرفية للمجتمعات؛ فلا يمكن لأمة أن تُحقق تنمية مستدامة وهي تُكرم محتوًى يُروج للسخرية من التعليم، أو يسخر من العلم والعلماء، أو يحتقر اللغة والفكر والثقافة؛ فصُناع التفاهة -وإن بدوا أفرادًا “غير مؤذين”- إلا أن تأثيرهم التراكمي يعادل ما قد تفعله الحروب الناعمة في إضعاف مناعة المجتمعات المعرفية والقيمية.
إن توصيات السياسات الثقافية يجب أن تتجه نحو بناء بيئة ذكية للمحتوى، لا تكتفي بالرقابة، بل تُفعل أدوات التوجيه والتحفيز الإنتاجي للمحتوى القيمي. نحتاج إلى منصات عربية ذات رؤية، تنقل الجمهور من الاستهلاك العشوائي إلى التفاعل الواعي. نحتاج إلى تعليم يُعيد إلى اللغة والفكر والعقل مكانتها، وإلى حملاتِ توعيةٍ تستهدف العقل الجمعي بأساليب حديثة لا تخاطب العقل من علٍ، بل تشاركه في صناعة الحلول.