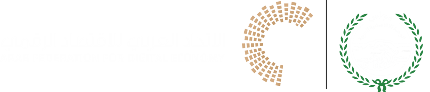أبوظبي
المصدر: جريدة الاتحاد
مفكرو الإمارات
أ.د. علي محمد الخوري
في عالم تُعيد فيه الرأسمالية رسم خرائطها، لم تَعُد مسألة الجذب الاستثماري مقتصرة على الحوافز والفرص، بل باتت مرتبطة عضوياً بما يمكن تسميته بـ«قابلية التوطن الرأسمالي»؛ أي قدرة البنية السياسية والاجتماعية والمؤسسية لأي بلد على استقبال حركة رأس المال العالمي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية مستدامة.
وفي هذا السياق يظهر الاقتصاد العربي فاعلاً محتملاً في المرحلة المقبلة من إعادة تمركز الرأسمالية العالمية؛ ليس فقط لما يملكه من موارد، بل لما يُمكن أن يطرحه من نموذج بديل إذا ما أُحسنت هندسة المسار.
وتتمثل الفرضية الجوهرية التي ينبغي تفكيكها هنا في أن الرأسمالية، بصفتها ظاهرة تاريخية متحركة؛ لا تستقر في فضاء معين إلا حين تتقاطع المصالح البنيوية مع القابلية المؤسسية والاجتماعية؛ فرأس المال، بصفته طاقة اقتصادية مشروطة ومؤدلجة؛ يبحث عن بيئات تتيح له المرونة والأمان والاستمرارية، وحين ينكفئ عن مناطق تقليدية -مثل أوروبا أو أميركا الشمالية- لأسباب تتعلق بفرط التشريعات والبيروقراطيات أو صعود الشعبويات الحمائية؛ فإنه يبحث عن بدائل قد تبدو في ظاهرها غير تقليدية، ولكنها تنطوي على إمكانات واعدة، والاقتصاد العربي هنا ليس استثناءً. وتتمتع المنطقة العربية بجملة من العوامل التأسيسية التي تتيح لها المنافسة على موقع متقدم في الخريطة الجديدة للرأسمالية المتنقلة؛ فإلى جانب الموقع الجغرافي الحاكم الذي يصل آسيا بأفريقيا وأوروبا، تملك المنطقة احتياطيات ضخمة من النفط والغاز؛ إضافة إلى صناديق سيادية تُعد من بين الأكبر عالمياً. كما تضيف الكثافة السكانية الشابة بُعدًا آخر للمعادلة؛ نظراً إلى ما تمثله من سوق استهلاكية صاعدة وقوة عاملة قابلة للتطوير؛ وهو ما يعني أن الاقتصاد العربي لا يعاني ضعفاً في مقومات النمو، بل يفتقر في كثير من الحالات إلى إعادة ترتيب الأولويات في ضوء قراءة جديدة لحركة رأس المال.

ولكن هذا المشهد الإيجابي سرعان ما تُعكره تحديات بنيوية تحول دون تحقيق النقلة المنتظرة؛ فمن جهة، لا تزال العديد من الاقتصادات العربية أسيرة الاعتماد على الموارد الأولية، وفي مقدمتها النفط؛ وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات الخارجية، ويفرض عليها نمطاً ريعيّاً يقلص من فرص التنمية الإنتاجية.
ومن جهة أخرى، فإن البيروقراطية الثقيلة، وضعف الشفافية المؤسسية، والافتقار إلى منظومات قانونية حديثة، تشكل حواجز فعلية أمام تدفق الاستثمار النوعي. وأما الاضطرابات الجيوسياسية في بعض الدول؛ فهي تحمل تكلفة مضاعفة لا تقتصر على الأمن المباشر، بل تمتد إلى تقويض الثقة بالبيئة الإقليمية بصفة عامة.
ولعل التجربة الرأسمالية العربية في دول مثل الإمارات والسعودية وقطر، تقدم نموذجاً يستحق التأمل؛ وهذه الدول لم تكتفِ بتدوير فوائضها المالية في الخارج، بل عملت على تأسيس منظومات استثمارية داخلية متقدمة، مستفيدةً من موقعها السياسي والاقتصادي، ومن قدراتها على التوجيه المركزي لمشروعات التطوير. وقد انعكس ذلك في تحولات هيكلية شملت البنية التحتية، والتعليم، واقتصاد المعرفة، وصولاً إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.
غير أن ما يميز هذه التجربة هو أنها لم تتعامل مع الرأسمالية بصفتها معادلة مالية فقط، بل مشروعاً اجتماعياً يهدف إلى إعادة صياغة الدولة والهوية الاقتصادية. وفي المقابل، تواجه دول عربية أخرى مأزقاً مزدوجاً، سواء بغياب الرؤية الاقتصادية المتماسكة، أو بهشاشة البنية السياسية والاجتماعية. وحين تتقاطع هذه المعضلات مع ضعف الاستقلال المالي؛ فإن نتيجة ذلك تكون بيئة طاردة لرأس المال، لا جاذبة له، حتى إن وُجدت الثروات الطبيعية؛ فالرأسمالية لا تُقيم في المكان الذي يحتوي الموارد فقط، بل في المكان الذي يوفّر شروط تحوّل تلك الموارد إلى قيمة مستدامة.
وفي ضوء ما تقدم، فإن منهج التعامل مع «حركية» رأس المال في السياق العربي يجب أن تتجاوز مفهوم «الجذب التقليدي»، إلى مشروع سياسي واقتصادي متكامل، يُعيد بناء الدولة بصفتها مؤسسة قادرة على إنتاج الثقة؛ فالمطلوب اليوم هو الانتقال من سياسة استرضاء المستثمر الأجنبي إلى بناء منظومة إنتاجية وطنية قادرة على المنافسة، تتكامل فيها السياسة الاقتصادية مع الرؤية التعليمية، ويتقاطع فيها الاستثمار مع البحث العلمي، وتتلاقى فيها الحوكمة مع الاندماج الاجتماعي.
إن بناء اقتصاد عربي قادر على استثمار الموجة الجديدة من «التحرك الرأسمالي» لا يكون من خلال السعي وراء رؤوس الأموال، بل عبر بناء نموذج يجعل تلك الأموال تأتي إليه. وهذا يتطلب إصلاحاً جذرياً في أنماط التفكير قبل السياسات، وفي المنظومة المؤسسية قبل المشروعات، وفي الثقافة المؤسسية قبل التشريعات.
وفي هذا المنعطف الدولي الذي يشهد إعادة تمركز للقوة الاقتصادية باتجاه الجنوب العالمي، تجد الاقتصادات العربية نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تنهض بمشروع تنموي متكامل يستند إلى بناء القدرة الذاتية عبر تحديث البنى الإنتاجية وتطوير المعرفة، وتوسيع الهياكل الاقتصادية العابرة للقطاعات التقليدية، وإما أن تنزلق إلى موقع استهلاكي تابع في اقتصاد عالمي تتجه بوصلته بعيداً عن مراكز النفوذ القديمة.
إن المسألة لم تَعُد تتعلق بالقدرة على مواكبة التحولات فقط، بل تتطلب جاهزية فكرية ومؤسسية لرسم مسار مختلف، ينبثق من الداخل، ويستند إلى شروط واقعية قادرة على إنتاج التميز لا تقليد المألوف.