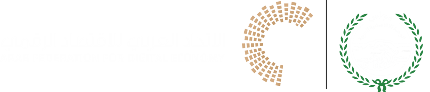القاهرة
المصدر: جريدة الوفد
أ.د. علي محمد الخوري
في عام 2025، دخل الاقتصاد العالمي مرحلة تشكل جديدة فرضت إيقاعها على مراكز القرار والسياسات التجارية حول العالم، ولم تكن الدول العربية بمنأى عنها. فقد أعادت الولايات المتحدة إحياء أدواتها الحمائية، وفرضت تعريفات جمركية مشددة على عدد من شركائها التجاريين، بما في ذلك تعريفات تخطت عتبة الـ100% في تعاملها مع الصين. هذا التحول لا يمكن قراءته فقط بوصفه الظاهري كسياسات جُمركية مجردة، بل في جوهره الذي يُعبر عن تحول أعمق في الفلسفة الاقتصادية الأميركية، يحمل معه تداعيات تتجاوز العلاقات الثنائية، ويفرض على الدول الأخرى، ومنها الدول العربية، إعادة ترتيب أولوياتها ومواءمة نماذجها التنموية مع بيئة دولية أكثر اضطرابًا.
ما يُثير القلق أن جزءًا من هذه التعريفات قد يمتد ليطال الصادرات العربية إلى السوق الأميركي، وهو ما من شأنه أن يُضعف موقعها التنافسي في تلك السوق التي لا تزال تشكل منفذًا تجاريًا مهمًا لبعض الاقتصادات العربية. فعلى سبيل المثال، سجلت صادرات المنسوجات المصرية والأدوية الأردنية مستويات عالية من التعرض لهذه الرسوم، مما قوض قدرتها على البقاء في دائرة التنافس مقارنة بمنتجات مماثلة من دول لا تخضع لذات القيود. هذا الواقع يضع صناع القرار في مواجهة سؤال حاسم: هل تملك الدول العربية المرونة الاستراتيجية التي تمكّنها من امتصاص الصدمة، بل وتحويلها إلى فرصة لإعادة بناء نموذجها الاقتصادي على أسس أكثر توازناً واستقلالية؟
أكثر ما يُقلق في هذا السياق ليس فقط فقدان الوصول التفضيلي إلى السوق الأميركي، بل ما يصاحبه من أثر غير مباشر على تكاليف الاستيراد، إذ إن فرض واشنطن لرسوم على واردات دول كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي يُفضي إلى ارتفاع كلفة المنتجات التي تمر عبر الولايات المتحدة أو تعتمد على مكوناتها. وتُعد قطاعات مثل الإلكترونيات والمركبات والسلع الإنشائية من أبرز المجالات التي قد تتأثر بهذه التغيرات، خصوصًا في دول الخليج التي تستورد كميات ضخمة من هذه المنتجات في إطار خططها التنموية.
لكن الخطر الأبعد من مجرد تذبذب التجارة يتمثل في احتمال التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن احتدام الحرب التجارية، وما قد يُرافقه من اضطراب في سلاسل الإمداد وتراجع في الطلب على النفط والغاز. هذا السيناريو سيكون مقلقًا بشكل خاص للدول الريعية التي تعتمد على تصدير الطاقة، إذ أن انكماش الطلب العالمي سيقود إلى ضغوط مالية، ويضع أمام هذه الدول خيارًا صعبًا بين مواصلة الإنفاق على المشروعات الكبرى أو الحفاظ على التوازن المالي. وتزداد خطورة هذا الخيار في ظل احتمالات تراجع التحويلات المالية من العاملين العرب في الخارج، نتيجة تباطؤ الاقتصادات الغربية نفسها.
وقد عكست الأسواق الإقليمية هشاشة هذه البيئة المتقلبة. فمع إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجديدة في أبريل 2025، سجلت بورصات الشرق الأوسط انخفاضات حادة، وشهدت موجات بيع سريعة عكست حالة من القلق الواسع لدى المستثمرين. إن فقدان اليقين بشأن مسار السياسات التجارية يخلق مناخًا من التردد في اتخاذ قرارات الاستثمار، وقد يُؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، وهو ما سيضغط بدوره على أسعار العملات وعلى قدرة الحكومات على تمويل خططها التنموية.
ومع ذلك، فإن في قلب الأزمة يكمن أيضًا مجال للفرص. فالظروف الاستثنائية كثيرًا ما تتيح نافذة لإعادة التفكير وإعادة ترتيب المسارات الاقتصادية. فبالنسبة للدول العربية، يمكن أن تمثل هذه الأزمة حافزًا قويًا لتقليل الاعتماد على الأنماط التقليدية القائمة على تصدير المواد الأولية، والتوجه نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا وقوة في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة، والاقتصاد المعرفي. كما أن انسحاب بعض الشركات العالمية من الولايات المتحدة لتجنب التكلفة الجمركية قد يدفعها إلى البحث عن مواقع إنتاج جديدة، وهو ما يفتح الباب أمام الدول التي تتمتع بميزة الموقع الجغرافي واليد العاملة، بشرط توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية مواتية.
كما أن التعريفات الأميركية قد تُسهم في إحياء الروح التجارية الإقليمية، من خلال دفع الدول العربية إلى تنمية أسواقها الداخلية وتكثيف تعاونها البيني في إطار منطقة اقتصادية عربية أكثر تكاملًا ومرونة. إن تطوير استراتيجيات بديلة للانفتاح على أسواق أفريقيا وآسيا وبلدان الجنوب العالمي قد يمثل ردًا فعالًا على انسداد بعض قنوات التجارة التقليدية، ويمنح الاقتصادات العربية فرصة للخروج من الهامش الذي وُضعت فيه ضمن النظام التجاري الدولي.
غير أن تحقيق ذلك يستلزم إعادة تموضع استراتيجي يتجاوز السياسات الظرفية. فالمطلوب ليس فقط البحث عن شركاء جدد أو أسواق بديلة، بل إعادة صياغة النموذج الاقتصادي العربي برمته. ويبدأ هذا من قراءة دقيقة لخريطة القطاعات الأكثر تأثرًا بالتعريفات، وتطوير أدوات دعم تتناسب مع خصوصيات كل قطاع، جنبًا إلى جنب مع مراجعة شاملة لسياسات الجودة، والتكاليف، والقدرة التنافسية، وهيكلة المؤسسات الإنتاجية على نحو يمكنها من الصمود في بيئة متغيرة.
كما أن التعامل مع الولايات المتحدة يجب ألا يُختزل في رد فعل سلبي أو تصعيدي، بل في بناء موقف تفاوضي متزن، يستند إلى المصالح المشتركة، ويفتح قنوات حوار لتفكيك دوافع السياسات الجديدة، واستكشاف مساحات التعاون الممكنة في ظل التغيرات الجارية.
ختامًا، يُمكن القول إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، على قسوتها الظاهرة، تطرح أمام العالم العربي اختبارًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد. إما أن يُنظر إليها بوصفها تهديدًا يفرض الانكماش والانكفاء، أو كفرصة لإعادة توجيه بوصلة التنمية خارج الدوائر التقليدية. إن اللحظة الراهنة تتطلب قراءة مختلفة، لا تكتفي بإدارة الأزمة، بل تسعى لتوظيفها كبداية لمرحلة جديدة، أكثر استقلالية، وأكثر اندماجًا في فضاءات اقتصادية بديلة، تُعيد تعريف موقع المنطقة العربية في الاقتصاد العالمي.
ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي أن يُطرح اليوم ليس: كيف نحمي أنفسنا من العاصفة؟ بل: كيف نبني مراكبنا الخاصة، لنبحر بثقة أكبر في عالم بات فيه الاستقرار استثناءً، والتحولات هي القاعدة.